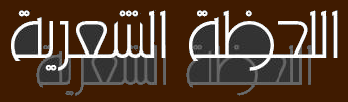|
سركون بولص: مشروع نص نقدي
فوزي كريم
شأن كثير من الشعراء، تتوزع حياةُ سركون بولص الشعرية على مراحل ثلاث: المبكرة، الوسطى، والنضج. في مقالتي النقدية هذه سأتوقف عند مرحلتين، الأولى والأخيرة، رغبة أن أؤكد حقيقة أجدها عماد كلّ مرحلة منهما. الأولى أن انصرافه للقصيدة التي تعتمد التفعيلة كان وراء توكيد أصالته، وشهرته، منذ الشروع في نشره المحلي. والثانية أن قصيدته في أمريكا لم تتأثر بقصيدة البيتز، ولا بأية مدرسة أمريكية مجايلة، كما يزعم كثيرون من نقاده، وكما يزعم محاوره، ويرتضيه هو في الحوار التالي لهذه المقالة. وسأُلحق بمقالتي النقدية جملةً من قصائد الشاعر المبكرة، التي لا أظن أنها نُشرت في كتاب، وأن الأجيال المتأخرة على معرفة بها. كما سأُلحق بها حواراً مطولاً، نُشر في واحدة من أهم المجلات الشعرية الأمريكية، قبل وفاته المبكرة بسنوات قليلة.
اضغط على الصورة لطفاً
كانت جماعة كركوك تتمتع بفضيلة معرفتها النسبية للإنكليزية، بسبب شركة النفط المُعتمدة كمصدر لدخل الأغلبية. وهذه المعرفة جعلتها تطمع برؤى أدبية جديدة تلوّح لها من وراء حدود العالم العربي. كانت هذه الرؤى ترد بيروت بالتأكيد، لتشيع بفعل إعلامها الثقافي الناشط داخل العراق كنار في هشيم، ولكن معرفة اللغة الأجنبية، والقراءة فيهل مباشرة، يُضفي مصداقية على محاولة اعتماد هذه الرؤى من قبل الكتاب الشبان. وأحسب أن سركون كان الأكثر تمكناً من هذه اللغة الإنكليزية بين جماعته، والأكثر موهبة. من كركوك كان سركون يبعث قصائده وقصصه إلى صحف بغداد، ومجلاتها. وكان أبناءُ جيله فيها يُقبلون على نصه بإعجاب ظاهر. حتى طمّع هذا الاعجابُ سركون والعديد من كتاب كركوك بالنزوح إلى بغداد. والمُلفت للنظر أن سركون، من بين كل جماعة كركوك، كان الأكثر اعتدالاً في التعامل مع مخيلته الابداعية، ومع التقنية في بناء نصه الشعري، ونصه القصصي. كان بالغ الحرص على أن يظل داخل مجرى الحداثة الشعرية العراقية، التي بدأت مع السياب وجيله، وامتدت مع الجيل الستيني. بدأ قصيدته الفتية في غمرة احتفاء بإيقاع التفعيلة، محاولاً أن يُملي موسيقاه الخاصة على هذا الإيقاع (شاركه فاضل العزاوي في هذا التوجه، ولعله سبقه إلى ذلك بزمن). ولم تُغره قصيدة النثر، مع أنها كانت شاغل كل شعراء كركوك المقربين له: مؤيد الراوي، جان دمو، صلاح فائق، ... الأمر لم يكن يختلف في حقل القصة القصيرة، التي كان يكتبها بمهارة. فمخيلته القصصية لا تفلت إلى الفانتازيا الخيالية، كما كان شأن مخيلة مجايليه: جليل القيسي، فاضل العزاوي، ويوسف الحيدري.
في ربيع عام 1964، تصدر عددَ مجلة "شعر"[i] الشهيرة في بيروت مجموعةٌ كبيرة من
قصائد سركون بولص، أرسلها من كركوك: إلى المسيح ـ سطور في الرمل، حيوان البراءة، الإطار، أشباهنا، قالوا أنت غريب، الموائد الباردة، قصائد للصيف: الأسطورة، البقاء، السنة الجديدة، الرسام، الأصفار، العزلة، فقراء، الذئب. خمس عشرة قصيدة مرة واحدة، وفي صفحات المجلة الأولى. قاعدة سركون التي اعتمدها داخل العراق أصبحت الآن إسمنتية. الأمر الذي شجعه للسفر إلى بغداد، والإقامة فيها. في العدد التالي (صيف 1964) قدمت له مجلة "شعر" مزيداً من القصائد (ثمان قصائد: المصابيح، الحافة، الليل، السرير، الضاحية، الميزان، الساعة والصقر، السخط) أرسلها من بغداد هذه المرة. أول قصيدة في "شعر" تبدأ هكذا:
سآخذُ منه يديهِ وأعطيه صمتَ الحياة الطويلة أقول له أيها الشبحُ الضائعُ أقولُ له أيها الضائعُ أجيء إليك بثوب المنافي، أجيء وأفتح كفي الهزيلة وأعطيك صمتَ الحياة الطويلة.[ii]
غنائية حميمة، ستتواصل معه بصورة أعمق في القصائد المتأخرة. على أنها في مرحلة التكوين التواقة، الطموحة الأولى كانت تتعرض لشطحات ذكاء، تريد أن تركب موجة حداثة لا تُحسن متابعة آثار أقدامها، سريعة الزوال، على الرمل. في القصيدة السابقة لا يعانق فكرة التضحية المسيحية فحسب، بل يعانق الديانة المسيحية ذاتها. تماماً كما عرفنا هذه المعانقة عند الشاعر يوسف الخال (مؤسس مجلة "شعر") في لبنان. فالخال كان مؤمناً مسيحياً كشاعر. ولعله الشاعر الديني الوحيد في الحداثة الشعرية العربية، الذي زاوج بين فرادة التجربة الدينية والتجربة الشعرية في تدفق واحد، مستعيناً دون شك بالشاعر تي. أس.أليوت. سركون بولص لم يكن كذلك. فهو غير متدين كما أعرف، ولكنه يجد في فيض "التضحية" المسيحية، وفي "الضحية" المسيحية كأقلية في مجتمع مسلم، وفي التطلع الجماعي لشعب عراقي مقموع، مادة شعرية مُلهمة:
سأعطيه قفلَ القرار وأحملُ عنه الصليبا أقولُ له خُذْ عصاي وجرّب طوافي أقولُ له في ارتجافي يضيّعني يا مسيحي يضيعني الزيفُ بين جذور السأمْ فأكسرُ خبزي وأشربُ خمري وأمضي غريبا.
هذه القصيدة تكاد تنفرد عن بقية القصائد الكثيرة التي نُشرت في مجلة "شعر" بصفة الوحدة الداخلية التي تغذي الرؤية الشعرية، وسياقها اللغوي، دون أن تتشظى في تلاحق فالت لاستعارات تسعى إلى الإدهاش وحده. قصيدة "قالوا له أنت غريب" يشاء سركون أن يرسم بورتريتاً للشاعر القادر، بفعل مجازات لغوية، على تحقيق معجزة يفلت عبرها عن أسار المنطق، الزمان والمكان. سحرية المجاز اللغوي في تحقيق التجاوز والتغيير كانت موجةً أدونيسيةً، طاشت في الستينيات، وأصبحت للأسف مطية سهلة لمواهب شعرية رديئة. على أنها لم تعدم التأثير على مواهب ممتازة، من طراز موهبة سركون:
يدفعُ الزرقةَ في عزلته كالعجلة يرفس القيظ، ويجتاز الإطار بضلوعٍ مقفلة شربت خمرَ الموائد مع أموات العصافير وأموات الحِكم مع أشباح القناديل وأشباح القياثر وانثنى دون قراءة يفتح التاريخَ كالكيس الأليف ذائقاً خبز المنارات وأسماك الحرائق ماسحاً أنف المهرّج مازجاً في نعل شاعر ظلَّ ناثر فاهماً أقداره والمطرا صافياً كالشجرة قادراً مُرّاً كرايات البراءة عالقاً بين عمارات الحرائق
قشّر البرعمَ في قبو النهار كاشفاً في ظلمة اليوم شراييناً عنيفة طيّرت عنه طيوفه فطوى الألفةَ واجتاز الغرابة نحو أفواه المصابيح وأبواب القرابة فاتحاً قبر السأم.[iii]
السأم لدى شاعر شاب لم يتجاوز العشرين من العمر موضة ستينية. ولقد عبَرت على سركون كما عبرت على كثيرين. في حين أن أسى هذا الشاعر المُستضعف الراغب بالتضحية أسوةً بالمسيح، بفعل تلك الوحدة في القصيدة التي مرّ ذكرها، وعدم الاستسلام الشكلي للمجازات الذهنية، ليبدو أسى حقيقياً ضارب الجذور. وسنرى ثماره تنضج مع الأيام في القصائد التالية لهذه المرحلة. أما "خبز المنارات وأسماك الحرائق" أو عماراتها، و"رايات البراءة"، و"قبو النهار"، و"أفواه المصابيح وأبواب القرابة"، وما بينها من صياغات جمل فعلية لا تقلّ قسرية، فأشبه بعربون مُفبرك للسيدة الحداثة.، التي كانت قابعة في بيروت، ولم تنحدر إلى العراق إلا في المرحلة الستينية. ولكن هذا المسار مُتوقع من شاعر واضح الموهبة، وبالغ الحساسية. وإذا ما كانت هناك ضرورة لإلقاء اللوم فعلى رياديي هذه الحداثة القسرية، التي اعتمدت اللعبة الشكلية والصوتية مع اللغة. لأن تأثيرهم كان ساري المفعول، في تلك المرحلة التي ضيق الإرثُ التقليدي الميّتُ على خناق التطلعات الشعرية الشابة. على أن صوت سركون لم ينفرد بهذه التأثيرات وحدها، ويعالج صياغة قصيدته وفق اعتباطها اللغوي، بل كان على مقربة أيضاً من أصوات رواد الحداثة العراقية أنفسهم: السياب، نازك، البياتي، البريكان... التي تلمس ظلّ تأثيرها خفيفاً على قصيدته:
أطفرُ من قاعات الصيفْ مرخيَّ العضلاتْ ذئباً يترصّدُ وعلين وعصفوراً من كلماتْ خوّاف العينين، يفرُّ النمرُ على أنفي ويدي، مبهوراً ينقضُّ على مأدبة اللحظاتْ لا أعرفُ خاتمتي لا أعرف إلا أنْ أمضي أن أبني بيت السنواتْ.[iv]
يمسّ ظلُّ البياتي هذا النص، ولكن خفيفاً مقارنة بملامح صوت سركون الذي ينمو بجرأة. يشير سركون في حواره المطوّل إلى أن البياتي " دفع الشعر الجديد خطوة إلى الأمام، موظفاً قاموساً شعرياً أكثر واقعية وبساطة، وشكلاً مرسلاً على السجية، وغنائية مكثفة." أشرتُ إلى أن سركون الشاعر لم يخرج إلى القراء بقصيدة نثر، مع أن صحبته الكركوكية كانت تكتب بخيلاء هذه القصيدة. ثم لم يستجب في مطلع حياته، هو المتابع والمعجب بمجلة "شعر" الطليعية، لمنحى قصيدة النثر فيها، مع أن المجلة كانت مكرسةً لهذه القصيدة، وشعراؤها كُثر: أنسي الحاج، شوقي أبو شقرا، عصام محفوظ، رياض الريّس، ألياس عوض، توفيق صايغ، جبرا إبراهيم جبرا... إلى جانب موجة الترجمات النثرية عن الفرنسية والإنكليزية. إرادته الشعرية في هذا الباب كانت، كما أزعم، تعتمد عاملين: معرفته لأوزان الشعر العربي المعزّزة بأذن موسيقية، ودراية بأن موهبته الشعرية، لكي تأخذ طريقها بشفافية، يجب أن تؤسس على قاعدة صلبة. ولقد حقق اعتماده هذا ما أراد. واستقبلته الصحافة الشعرية العراقية، والعربية بأذرع مُشرعة. قصائده المبكرة تنطوي، إلى جانب ما اعتبرتُه كليشيه بلاغة طليعية آنذاك، على التماعات فتية لا تخفى، في عمق أساها: العاهراتُ على الشوارع، يرتدين الثلجَ تحت معاطف الفرو الثقيلة. والشمس في العتبات مائدة الثلوج، تمرّ بالشرفاتِ مُطفأةً قتيلة. وتموتُ في الطرق الطويلة.[v]
أو على التماعات في عمق تطلعها الإرادي :
أقصى حبي أن أقصمَ ظهرَ العزلة لتظلّ معي.[vi]
2
في صيف 1967، وبعد نشر قصائده في مجلة "شعر"، ولقائه برئيس تحريرها يوسف الخال في بغداد، أصبح تحقيق حلم السفر إلى بيروت، حاضرة الحرية الفكرية والسياسية، ممكناً. وبدون جواز سفر أنجز ذلك على عجل (راجع الحوار). ولكن هلْ من فارق بين نزوحه السابق من كركوك إلى بغداد، وهذا النزوح من بغداد إلى بيروت. قد تتنوع الأسباب الشخصية وراء نزوح الأدباء العراقيين إلى بيروت آنذاك، وفيما بعد ذلك بعام، أو بعشرة أعوام. ولكنها تتوحد تحت هاجسٍ عام واحد، هو هاجس الهرب. أنا الأخر نزحت إلى بيروت بعد عام من سفر سركون، ثم بعدي بأقل من عام بدأ الخروج الأوسع لعشراتٍ من أصدقائي الكتاب والشعراء. دافع الهرب كان هاجس الجميع، ولقد طويت ذلك في قصيدة قصيرة كتبتها بعد الخروج الكبير الذي بدأ أواخر عام 1978:
كلُّ شراعٍ، لمْ يعُدْ إليكِ يا مخافرَ الحدودْ، لا باحثاً سُدى عن المعنى، ولكن هرباً من المعاني السودْ، فهو شراعي.
هاجس الهرب مما حدث، ومما سيحدث. الهرب من ضيق الأفق المُسيّس، حتى لو أسهم فيه الأدباء والمفكرون أنفسُهم جميعاً. الهرب الفردي من طوق الجماعة غير المنسجمة. الهرب مما لم يتحقق إلى احتمال أن يتحقق في المجهول. وهذا الهرب الفردي الذي شمل كثيرين، كان هرباً حزيناً، مذعوراً ولكن بصورة غير ظاهرة. ليس فيه من مسرات السفر، وتجاوز الحدود إلا النزر اليسير. اضغط على الصورة لطفاً
نزوح سركون إلى بغداد كان على خلاف ذلك بالتأكيد. كان نزوح الباحث عن المعنى المضاء، والساعي إلى تحديد الهوية، وإلى قطف الثمار. ولكن نزوحه إلى بيروت، بالرغم مما ينطوي عليه في الظاهر من معاني البحث عن المعنى واكتشاف النفس، إلا أنه في جوهره نزوح الهارب. يوحي في حواره بشأن النقطة الأولى: " كانت بيروت تستحق عناء المغامرة. كانت متوسطية الروح أكثر منها عربية. فيها أدركت معنى أن أكون حراً: في أن تقول، وتنشر ما تؤمن به. ترجمتُ هناك غينزبيرغ، سنايدر، ماكليور، فيرلينغيتي وآخرين لمجلة شعر، وكتبت عنهم بأسلوب متغطرس، وبإطناب، واصفاً مشاهد الساحل الشمالي في سان فرانسيسكو بالرغم من أنني لم أكن هناك!" وبشأن الثانية: " زمني في الإقامة البيروتية كان قصيراً. أحد السفلة الغيورين كان قد أخبر الشرطة اللبنانية بأني دخلت البلد دون تأشيرة. دبرت ملاذاً أختبئ فيه إلى حين، أنام على صخور الروشة الساحلية. ولكن الشرطة ألقت علي القبض بيسر ورمتني في السجن. لقد خُيرتُ بين أن أُعاد إلى العراق أو أذهب إلى أرض أخرى. اخترت الثانية بطبيعة الحال. ولقد حدث أني خرجت في الوقت المناسب، فالحرب الأهلية اندلع بعد غيابي بوقت قصير." بين كمّاشتين شعورٌ أكثر ملموسية لدى الشاعر من ذلك الطرب للحرية الجديدة، وللساحل الخيالي في سان فرانسيسكو. ودليلي على هذا صوت الشاعر الداخلي العميق، الكامن في قصيدته. في شتاء 1969 نشر سركون واحدة من أروع قصائده، في مرحلته الوسطى هذه، تحت عنوان "آلام بودلير وصلت"[vii]. رائعة لأنها مُحكمة، نظيفة من أية
مباهاة عضلية في لغتها الشعرية، صادقة لحد أنها أبكتني صادقاً، حين قرأتها وقت صدورها، وكنت على وشك الرحيل إلى بيروت. يسيرة بعمق، واستعارية دون اعتباط . لم التقط دلالة العنوان إلا افتراضاً، فأنا اعرف أن بودلير، الضيق بالحياة العائلية والحياة الباريسية، قد شرع بسفرة بحرية طويلة الأمد إلى الشرق، على سفينة تُسمى "السماوات الجنوبية"، في التاسع من حزيران عام 1841، وكان في العشرين من عمره. وعلى متن السفينة صار يشعر بالوحدة وبموجة كآبة. ثم تعرضت السفينة إلى اضطراب جوي عاصف على مقربة من رأس الرجاء الصالح، حتى قاربت فيه على الغرق. وأنه استطاع على مقربة من الساحل أن يشق طريقه في
الماء الهائج بصورة مدهشة.[viii]
هل أن آلام بودلير تلك قد وصلت سركون في بيروت، أم أن سركون قد تقمص شخص الشاعر بودلير، وكأنه أراد أن يوحي بذلك في قوله:
هناك باخرة ضائعةٌ ترعى بين أحشائي وأصادف ذات يوم ملابسَ بودلير الداخلية في طريقي. كيف وصلت إلى بيروت. آلام بودلير وصلت عن طريق البحر.
هل "وصلتْ" أم "وصلتُ". للأسف ما من حركات إعرابية في النص المنشور. ولكن لا بأس من إرباكٍ إضافي إلى هذا التداخل الشعري الرائع: وصلتُ إلى الحد. في الأصل كنت راعياً يفترس أرخبيلاُ ممزقاً من الأرواح، في الماضي الذي لا يمكن صيده. أخرج إليه فيهرب: غزالةٌ تأكل الملح على بابي. أيّ ملح بقي لي أيها الماضي؟ جننتُ من الإفلاس والمحبة. وذات ليلةٍ تحول إفلاسي إلى طير ومحبتي إلى جمرة. هرب الطيرُ، وبقيت الجمرة. في الجمرة دخلتُ أخيراً.
هذه القصيدة كُتبت في بيروت التي رآها "مكةً حقيقية لكل شاعر" (الحوار). بعد أن غادر العراق مُكرها. متطلعاً إلى الآتي من الضفاف الأمريكية الغربية البعيدة. ولكن كلُّ خطوة في القصيدة تُنبئ بأسى عميق مما حدث، وبارتياب عميق مما سيحدث. "وصلتُ إلى الحد." يقول في مطلع القصيدة. وكأنه يُلقي بعُدة السفر على مشارف النهايات القصوى. ما من شيء بعد ذلك. وحده الماضي يَشغل أفق الروح لدى الشاعر، "الماضي الذي لا يمكن صيده./ أخرج إليه فيهرب". في العدد 40 لخريف 1968، أي قبل عام من قصيدته هذه، ترجم سركون عددا من قصائد "البيتنكس". ولقد وردت في قصيدة غاري سنايدر "أشياء لتفعل حول كوة" هذه الإشارة: "ضع في الخارج ملحاً للغزلان"[ix]. ولعل الصورة ، أو ربما الفعل، لقيا صدى في
نفس سركون، فطوّر المشهدَ لصالحه، جاعلاً الغزالة تأكل الملح، الذي أمر به الشاعر سنايدر، على بابه، من أجل أن يتضرع: "أيّ ملحٍ بقي لي أيها الماضي؟". هو الذي لم يبتعد عن ماضيه إلا قرابة العام الواحد! إن هذا الشعور بالفقدان سيأخذ مدى بعيداً في حياة سركون، وشعره. وهذه القصيدة التي تؤرخ له المرحلةَ الوسيط بين الوطن والمنفى، بين البيت العائلي وضياع الابن الضال، ستتجذّر وتتفرّع على مدى الأربعين سنة القادمة. ولكنها ستكشف قبل هذين الطبيعة الإنسانية لهذا الشاعر: تشرده، وقلبه المحب. وهي خصلتان لا يُخطئهما من يعرفه عن قرب، أو يتعرّف عليه. كان انطباعي هذا لا شائبة فيه حين التقيته في بغداد في الستينيات، والتقيته في بيروت في الفترة الوجيزة قبل سفره، وفي لندن عند زياراته المتكررة. والمحزن أن الخصلتين عادة ما تستعين بثالثة، تُعينهما على مقاومة الحياة ومشقات الروح، هي الإدمان على الخمرة. وكنت أُخبره، حين ينهي زجاجة الكونياك الأثيرة، بأني وافرُ الجبن مقارنة به، فأنا معطوب القلب مثله، ولا أملك جرأته في الاقتراب من الكأس، مع أني أود لو أحتسي الخمرة من "فوّهة القنّينة، حتى يبتلّ قميصي...تدمى رائحتي، وتشفّ الروحُ من الجسد.." (وردت في قصيدة "قارات الأوبئة"). وهو يُنكر أن يكون للخمرة هذا الأثر الضار على القلب: "لك يا أخي هذي خرافة، زين"، ويتدفق بالضحك. في القصيدة ترد الخصلتان عاريتين: "جُننتُ من الإفلاس والمحبة." ويتحول في ليلةٍ إفلاسه إلى طير، ومحبتُه إلى جمرة. الطير يهرب، والجمرة تبقى، ليدخلها وينزلُ إلى أحشائها ويحفر جمالها، ويتيقن من عمق عزلتها:
لن أخرج لنْ يخرج الرجل. ...... قالوا لي أترك الجمرة. وفي غرفتي ازدحمت نصائح ذات قامات طويلة. وخرجتُ من غرفتي إلى غرفة الجمرة. نزلت ثانية. كانت رحلةً طويلة. رحلة طويلة كانت لا يعرف فيها أحدٌ احدا. لا يشرب أحدٌ غير أحشاء صديقه المخلص. ....... نمتُ طويلاً في سفن الضعف. قلت قودوني إلى الحرب لأشفى ورأيتُ جمرتي. قلت قودوني إلى الحرب لأشفى ورأيت جمرتي تنتظر. الغزالةُ تأكل الملحَ على بابي. أيها الماضي أيها الماضي ماذا فعلت بنفسك أيها الماضي. وذات ليلة تحول إفلاسي إلى طير ومحبتي إلى جمرة. حلّق الطير وحده على الجمرة. بقي الطير ينظر إلى الجمرة حتى انطفأت الجمرة. أيها الماضي أيها الماضي ماذا فعلتُ بحياتي؟ حركةُ الإعراب في "فعلتُ" حسمت الأمر لصالح قوة القصيدة. فلقد سبق أن عاتب الماضي قائلاً: "ماذا فعلتَ بحياتك؟"، والآن اللحظة الحاسمة لمحاسبة النفس. فالماضي فعل ما فعل لنفسه، حتى جفّله عن مكانه، فهرب هو الأضعف. ولكن لمَ كلّ هذا الضعف ليفعل بنفسه ما فعل؟ وأي تساؤل تضرّعي في البيت الأخير، والشاعر يعترف أن إفلاسه يحلّق فوق محبته، يراقبها وهي تنطفئ؟
3
حين نشط سركون مع جماعة مجلة "شعر"، في مرحلة إقامته الوجيزة في بيروت، ترجم لهم مختارات من قصائد البيتز الأمريكية، وقبلها بعدد واحد ترجم مختارات تحت عنوان "أين هي فيتنام؟" مع تخطيطات معبرة من الفنان العراقي وضّاح فارس. المجموعتان متعارضتان في التوجه الشعري الأمريكي. ولقد وضح ذلك التعارض في مقدمتي سركون للمجموعتين. في الأولى يوضح: أن "الشعر الحديث لا يؤذي، فهو يكتفي بتشريحات سعيدة، لحالات أغلبها متفسّخ، وحافل بالمرض. وخصوصاً الشعر الأمريكي. طيلة هذا القرن، من وجهة نظر التزامية، لم يحدث أن برز شاعر، أو على الأقل قصائد بذاتها، تتمسك تمسكاً خالصاً وعميقاً بالدفاع عن السلام والإنسانية أو مكونات نظيفة أخرى. هناك قصائد تتحدى العالم من أجل التحدي. وشعراء أيضاً يتكلمون وأفواههم، اعتباطاً، مزبدة بالغضب والتهديد..."[x] يبدو
سركون هنا متعاطفاً بحرارة مع القلب الإنساني المفقود في الشعر الأمريكي، الذي أعطته حرب فيتنام مُتنفساً لكي يحتج، متضامناً مع الضحايا، ومُحتجاً ضد القتلة. في المقدمة الثانية حول حركة البيتز يبدو سركون أقلّ وضوحاً، مجذوباً بالتهويم الذي يمليه عليه شعرُ البيتز، وسلوكهم: "هلْ القصيدة في الأخير هي هذا النوم الميتافيزيقي المتفسخ والوارد في كل الشعر التاريخي حتى الآن؟ هل هي استجداء في وسط الهدير الداخلي الذي يهدد بالقصف، على حافة المحيط الأسود المتلألئ بزجاجة الحلم، اللاوعي الذي هو النظافة المطلقة والمتآمرة، من جانب آخر، أيضاً على قتل الجسد وطرحه في بقية القمامة الكونية؟..."[xi] هذه اللغة
ليست غريبة على ستيني في الرابعة والعشرين من العمر، يرى في الشاعر "المخلوقَ الذي يخرج إلى العالم وفي نيته أن يصطاد سمكة الأبدية." ولكن الذي أود أن أُلفت النظر إليه في هذه الشواهد هو هذا الإنكار المُضمر لنزعة التحدي من أجل التحدي في ذاته، والرغبة في التطلع "غير المتفسّخ، وغير المرضي" إلى السمو الإنساني. إن كياناً مفعماً بالأسى، بفعل الاقتلاع والغربة في وطنه، أو خارج وطنه، هاجس أصيل لدى سركون، منذ مرحلته المبكرة. إن المتحدث في قصيدة"آلام بودلير وصلت" هو صوت الشاعر ذاته دون أدنى شك. ولمسة الأسى العميق في صوته أعلنت انقلاباً غير مُعلن في طبيعة قصيدته: موضوعاً، صوراً، ومفردات. لم يعد يحفل بـ "خبز المنارات وأسماك الحرائق" أو عماراتها، و"رايات البراءة"، و"قبو النهار"، و"أفواه المصابيح وأبواب القرابة"...الخ من العبث اللغوي. بل صار معمارياً، وبقي كذلك على ما أعتقد، بالرغم من أني لم أتابع كل مجاميعه الشعرية، باستثناء "الأول والتالي" (1992) و "عظمة لكلب القبيلة"، مجموعته الأخيرة التي بين يدي الآن، والتي تؤكد زعمي. حين صدرت مجموعة "الأول والتالي" كتبتُ حينها: " بدأ سركون اتجاهه لكتابة قصيدة النثر بكثافة بعد سفره الي أمريكا ولكن أصالة تجربته أفردت قصيدته عن الشائع في كتابة قصيدة النثر . فهي قصيدة تؤخذ بالتجربة الروحية . وتجربتها الفنية هي محاولة دائبة للوصول إلى وحدة بين العمق والوضوح . وإلى وحدة في البنية، بلا لعب ذهني أو زخرف لغوي . الصورة المجازية في نصه لا تكتفي بذاتها ، إذا ما توفرت ، وهي ليست هدفاَ مغرياَ على كل حال . وقصيدته توكيد على أن مهارة الصورة المجازية الصادمة هي مهارة عضلية، ولا تشغل شاعراَ مهموماَ بالقلق الروحي، الباحث أبداَ عن وحدة بين العمق والوضوح، والتي تتطلب مهارة نوعية." وما كنت أعنيه بالتجربة الروحية هو التجربة الداخلية النادرة بالضرورة. التجربة التي تتمثل لدى سركون بـ " .. لوعات الفرد المنفي ، الفرد الأعزل التي ألقت به العواصف على ساحل مجهول غريب . وكأن عواطف الشاعر قد ازدحمت فجأة بفعل هذه المواجهة المفاجئة. وكأن الشاعر ينفرد بنفسه لأول مرة، متسائلاً أمام أوصال جذوره المقطعة . أمام كيانه الذي أصبح ذاكرةً كله . أمام حاضر لا ينتسب إليه، قاسٍ كالحِ الوجه، لا إنساني . ثم تهب عليه كأنسام ليل صيفي فائقة العذوبة، تفاصيلُ الأيام القديمة ، أيام قراه ومدنه ووطنه كله."[xii]
هذا الحنو على الماضي لا يبدو مغرياً كفاية لشعراء ونقاد تيارات ما بعد الحداثة. في الحوار المطول ألذي أنشره بعد هذه المقالة يسأله السيد ريان الشواف بما يلي: "ر.أ: الحنين، وليد المنفى المحتوم، يكاد يكون عنصر ثابت في الشعر العربي المعاصر. ولكن شعرك غير متطرف في هذا، وكتاباتك بصورة عامة غير مشرّبة بهذا التوق لزمن ومكان مختلفين. هل يعني هذا نوعاً من التكيف مع محيطك الجديد، وتراجعاً تدريجياً عن أهمية العراق في داخلك، أم هو نتيجة جهد من قبلك تؤكد فيه أن شعرك ليس أُحادي البعد ومتسم بالتكرار؟ س.ب: أستطيع أن أقول باطمئنان أن معظم كتاباتي منذ تركت العراق كانت محاولة بالغة الجهد عبر مئات القصائد للتعامل فنياً مع ما سميته الحنين. وكشاعر، أخشى أن أقع في أحبولة الإسراف العاطفي، على أني لم أتوقف لحظة عن التفكير بوطني أو التشوق لرؤيته. أمريكا بالنسبة لي هي مكان عيش، إقامة، وليست وطناً، لأنك لا تستطيع أن تملك وطناً مرتين. وفي نفس الوقت، ليس بمستطاعك أن تعود الى وطنك ثانية. اللغة العربية، وهي الحبل السري الذي يربطني بشعبي وبتاريخي، هي الوطن الحقيقي الوحيد الذي أملك. وهنا نقطة حاسمة أريد أن أثبتها: التقنية الشعرية التي طورتها عبر السنوات، لكي أعالج هذا الموضوع الضخم الذي هو المنفى، هي ما حال بيني وبين السقوط في أحبولة الحنين. إذا لم تتحول العاطفة إلى فن، فالأولى أن أحتفظ بها لنفسي وحدي." الحذر هنا ليس من احتضان الماضي، والتنفس في رئة الذاكرة، بل من "الميوعة العاطفية". وقصيدة سركون منيعة عن هذه الميوعة بالتأكيد.
قصائد تلك المرحلة، شأن قصائد المرحلة المتأخرة، لا
تكاد تنفصل مشيمياً عن قصيدة "آلام بودلير وصلت". فسركون دخل بيروت
هارباً ليغترب، ودخل سان فرانسيسكو لائذاً ليغترب، أوجع ما يكون عليه
الاغتراب.ولكنه لم يُخدع بملاذ لا يضمّد جرحاً:
ما أريد أن أعاود تأكيده هنا هو أن سركون حين ترك العراق هارباً ليغترب في بيروت وأمريكا، إنما ليغترب كإنسان بين الناس، وكشاعر بين الشعر والشعراء. إن قصيدته تُنبئ عن قطيعة بينه وبين الشعر الذي تطلّع إليه من بغداد وبيروت، والشعر الذي خبره وخبر شعراءه في سان فرانسيسكو. إن قصيدته لا تعكس لمسة شعرية ولو صغيرة، وليدة من المحيط الشعري الأمريكي في مراحل ما بعد الحداثة، والبيتز، أو جيل الغضب ضمناً. بالرغم من إقباله على قراءته بحرص، وعلى صحبة شعرائه. بالرغم من رغبة محاوره التأكيد على هذا التأثر المفترض. يكتب في مقدمة الحوار: " ... سرعان ما وجد بولص ضالته في صحبة شعراء "البِيت" Beat المحليين، الذين تميزوا من خلال منشوراتهم ، صار يتعرف لأول مرة على بلده الجديد. والواقع انه ، بمعنى من المعاني ، ظل يدور في فلك "البِيت" منذ ذلك الحين. مع ذلك فقد ظل يكتب في اللغة العربية على وجه الحصر.... ورغبة لمعرفة المزيد عن بولص والتفكير بأن شاعراً عراقيا مسيحياً من الـ Beat الجدد ، قد يكون ذا فائدة للقراء الأمريكيين ، لاسيما في ظل الظروف السائدة اليوم ، جعلني على اتصال معه ، مقترحاً حواراً معه."
هذه الرؤية ليست صحيحة، ولا تعززها إجابات سركون
ذاته. بل على العكس، فهو يتعارض معها منذ أيام بيروت، كما رأينا. حتى
في إعجابه بقصيدة مثل "عواء" التي ترجمها إلى العربية بحماس، وإعجابه
بشاعرها غينزبيرغ، إلا أنه لم يستجب روحياً، وداخلياً مع مادتها. يسأله
السيد ريان: "من
الواضح
أنك تأثرت
جدا
بحركة البيتز.
كيف تردون على هؤلاء المنتقدين الذين
أنكروا حركتهم؟
الإجابة لا تنطوي على معنى "التأثر جدا"ً بحركة البيتز. ورأيه بأنها حركة مثيرة، ومدهشة في بعض نصوصها، رغم أن أكثرها "لم يتواصل"، لا يعني تأثراً، بل هو حكم نقدي، يمكن أن يتوفر لكل شاعر. والشاعر سركون، على امتداد الحوار الطويل وفي كل مجاميعه الشعرية، ليس إلا شاعراً عراقياً بصورة بالغة الحميمية. إن حركة البيتز، وكل حركات الشعر الأمريكية التي تنتسب إلى "ما بعد الحداثة" (الشعريات الشفوية، الشعر الاستعراضي، الشعر البصري لمدرسة نيويورك، وشعر اللغة...)، كانت ذات توجه تجريبي، صادم في نزوعه الفني الجديد، مُنقطع عن حداثة أوائل القرن العشرين، ميال إلى تفكيكية في التعبير، وتجنب الأنا التي يرونها برجوازية، وهي ـ كما يرى جوميسون ـ "تعبير كامل عن الثقافة الرأسمالية المتأخرة وهي تحت سطوة مجموعات بشرية متعددة الأجناس والقوميات." وإذا كان رأي جوميسون صواباً، فإن تفكيكية التعبير يتحتم أن تكون عرَضاً دالاً على فقدان الهوية في المجتمع الاستهلاكي." "إن كتابة البيتز شعبية، مباشرة، استعراضية، انجذابية تصوفية، مُعذّبة، شفهية وتعويذية، مع جذورها الممتدة في شعر بليك، ويتمان، وكارلوس وليمز. إنها غير مُحتشمة وواعية روحياً في الوقت ذاته...كان غينزبيرغ يتناول المخدرات، ولقد طُرد من جامعة كولومبيا بسبب كتابته غير المحتشمة في غرف الطلبة الداخلية، وقضى زمناً في جناح الأمراض النفسية في مستشفى رويكلاند. في وقت يتطلب الشعر فيه شكلاً، لياقة، صفاءً، ولاشخصية، كان شعر غينزبيرغ حيوياً، مباشراً، تجديفياً، انفعالياً خطابياً....". حتى فيما يتصل بالمرحلة المجايلة لوصول سركون إلى سان فرنسيسكو، حين ظهر جيل قصيدة النثر المتأثر بالتوجه السوريالي الفرنسي، بدا " أن شعراء قصيدة النثر ذهبوا في اتجاهين: البعض مثل تشيرنوف وأديسون كتبوا حكايات قصصية، وخرافية، وما وراء قصصية. وآخرون ارتبطوا بجماعة "شعر اللغة" (رون سيليمان، هيجينيان...) وهم يستعملون الشكل لتوكيد "وحدة"َ الانتباه من البيت الشعري إلى الجملة الشعرية، أو الجملة المتشظية، أو الفقرة..." [xiii]
قصيدة سركون، الذي عاش أكثر من ثلثي حياته وسط هذا الشعر الأمريكي، لم تستجب إلا بمقدار ما تتوافق مع مقدرات قصيدته العربية، وهواجسه الشعرية العربية، وذاكرته العراقية القروية، التي شممنا رائحتها بعمق في "آلام بودلير وصلت"، وما يُحيطها قبل الرحيل النهائي. اللغة العربية التي تجددت في داخله هي التي تستقبل المؤثرات العجيبة المدهشة، والتي ظلت غرائبية، لتعيد الصياغة شعرياً. يقول في (الحوار المطوّل): ". أمريكا بالنسبة لي هي مكان عيش، إقامة، وليست وطناً، لأنك لا تستطيع أن تملك وطناً مرتين. وفي نفس الوقت، ليس بمستطاعك أن تعود الى وطنك ثانية. اللغة العربية، وهي الحبل السري الذي يربطني بشعبي وبتاريخي، هي الوطن الحقيقي الوحيد الذي أملك." الوطن الشعري الوحيد. وهذا بالغ الوضوح في قصيدة سركون.
[i] شعر، عدد29، شتاء ـ صيف 1964. سنعتمد هذا المصدر في كل شواهد القصائد المبكرة. 2 عدد 30 صيف ـ خريف 1964. 3 عدد 29، ص14. 4 السابق، ص23. 5 السابق، ص16. 6 السابق، ص21. 7 العدد 41، شتاء 1969. 8 التفصيل في Baudelaire, by Enid Starkie, Pelican Biographies 1971, p.65 9 عدد 40، 1968، ص.66. 10 عدد 39، 1968، ص37. 11 عدد 40، 1968، ص64. 12 اللحظة الشعرية، 13 Postmodern American Poetry, Adited by Poul Hoover, 1994 (المقدمة الدراسية)
|
|
||
|
|||