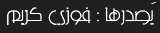|
السبعينيون.. الجيل المبتور
عواد ناصر
رغم ما قيل حول تحقيب الأجيال، فإن كلمة "جيل" تساعد، كثيراً أوقليلاً، على تزمين مرحلة وإن افتقر الأمر إلى الدقة النقدية الحازمة، وأشعر أن كلمة "جيل" هي الأكثر تداولاً في بلد مثل العراق، والأنسب، منها في أي بلد عربي آخر. لعل الأمر ينبثق من الظاهرة السياسية العراقية التي شكلت فيها (العشريات) منعطفات حادة في حياتنا: العشرينات عقد تشكل الدولة العراقية. الثلاثينات عقد المعاهدات الدولية التي ربطت العراق بأحلاف استعمارية/ وثبات وانتفاضات مناهضة. الأربعينات عقد الانقسام الحاد بين دول المحور بمواجهة بريطانيا. الخمسينات بداية التململ الوطني والقومي، بالبزة العسكرية للانقضاض على الملكية. الستينات: عقد الانقلابات العسكرية، ومنها ما هو مضحك حتى أن ضابطاً كبيراً، إسمه عارف عبدالرزاق، كان يشغل منصب رئيس الوزراء قام بانقلاب عسكري (فاشل). السبعينات هو عقد الدكتاتورية وهي في مرحلة التدريب لتبلغ كامل لياقتها العنيفة نهاية العقد هذا. الثمانينات عقد أطول حرب تافهة في العصر الحديث بين العراق وإيران (الحربُ شتاءٌ/ تهطل فوقنا، جثةً جثةً، من شجرة العائلة – قصيدة بعنوان "الحرب" – كتبت عام 1996). التسعينات عقد الحصار الذي لم يرحم حتى مثقفي السلطة أنفسهم فباع بعضهم حتى نظاراته الطبية. عقد الألفية هو عقد الحرب الأخيرة وسقوط الحاكم والمحكوم معاً، وما زلنا نعيشه، أو نموته، لا فرق. كان هذا هو المناخ العام الذي تحركت فيه قصائد العراقيين لتجيئ ثقيلة الوطأة، مثقلة بالتوتر السياسي (الآيديولوجي) حتى أن معظم شعرنا الحديث صار ينوء بالشعار والشعار المضاد، في انقسام حاد جعل من الشعر ميداناً لفظياً يجاور الميدان السياسي والعسكري أويشتبك معه، حليفاً أو مناوئاً، فضعفت هواجس القصيدة العراقية المتعلقة بذلك الإخلاص الشديد للشعر لا لغرضه، أو بتعبير آخر: ضاقت تلك الفسحة الحساسة، شديدة الهشاشة، التي يكون فيها الشاعر مع قصيدته باعتبارها غاية فنية قصوى وليست وسيلة من الوسائل.. حتى لو فهمت هذه العبارة بأنها إعادة انتاج للفكرة الشهيرة: الفن للفن.. فليكن. طبعاً، ثمة استثناءات لكنها معدودة، وكذا ثمة استثناءات حتى في تجربة الشاعر الواحد. تحقيب الشعر وأجياله أصعب من تحقيب السياسة وأجيالها، فالشعر مساحة بلا أبعاد، وكلمة "مخضرم" جاءت من القاموس الثقافي، أولاً، لتحتشد في قاموس السياسي فيما بعد.. أي أن شعراء كتبوا ونشروا بين جيلين، وهم كثيرون. شعراء جيلنا، السبعيني، أبناء مشروع مبتور، مثل عشرات المشاريع الفكرية والسياسية والاقتصادية والفنية في العراق، بل هم ضحية البتر مرتين: الأولى هي عندما جرى بترهم سياسياً، إذ أن تجربة الشعر السبعيني، في العراق، ممثلة بالأبرز منهم والأكثر حضوراً، كانوا شيوعيين أو من أصدقائهم أو قريبين منهم، وساعد على ظهور هذا الاتجاه، بين عوامل أخرى، وجود مطبوعات الحزب الشيوعي العراقي (الفكر الجديد – أسبوعية – والثقافة الجديدة – شهرية – ثم طريق الشعب – يومية – ثم عودة الفكر الجديد، عربية/ كردية – أسبوعية، من قطع التابلويد) وهي مطبوعات استقطبت جمهوراً واسعاً من الكتاب الشباب والقرّاء، معاً، بعد فسحة ستينية لكنها من نوع مختلف (لجهة وضوح النبرة اليسارية الجديدة). من ناحيتي لم أنشر، خلال وجودي في العراق (حتى بداية عام 1979) أي نص في مطبوعات الدولة، غير قصيدة واحدة في مجلة (الأقلام - شهرية) وهي قصيدة ساعدتني أثناء تأديتي الخدمة العسكرية الإلزامية، وفي مصادفة عجيبة عندما كان آمر الفوج شاباً يتابع بعض المطبوعات الأدبية وفي مقدمتها (الأقلام) إذ منحني إجازة (نصف ليلة) وأعفاني من عقوبة السجن ثلاثة أيام وحلاقة الشعر (نمرة صفر) لأنني أكملت الليلة ولم أكتف بنصفها، بإغراء من صديقتي الجامعية (ميم سين). بخلاف الكثير، من اصدقائي وزملائي، لم أنعم بحياة مدنية أو ثقافية، أسوة بهم، على بؤس تلك الحياة وفقرها المدقع، فقد سوقت إلى الجيش، جندياً مكلفاً، منذ العام العام 1972، وهو عام تخرجي من معهد إعداد المعلمين – بغداد حتى أواخر عام 1975، وما هي إلا شهور معدودات حتى سوقت ثانية، جندياً احتياطاً، لأمضي ما يقارب السنة حتى سُرحت نهاية عام 1976!. على أن الأمر لا يتعلق بحياة العزلة القاسية التي يحياها الجنود غالباً، وحسب، بل عشت حياة عسكرية بالغة الخطر، إضافة إلى خطر الأمكنة التي عملت بها (كردستان) حيث الحرب الفعلية مع الكرد، لأنني كنت عضواً في الحزب الشيوعي العراقي، وقتها، ومعنى هذا أنني معرّض لعقوبة الإعدام في أية لحظة (حسب قانون نشر في جريدة الوقائع العراقية يقضي بإعدام اي عسكري ينتمي لغير البعث) وما أسهل ذلك إثر تقرير حزبي من زملائي الطلبة البعثيين (في منظمة الاتحاد الوطني للطلاب – تنظيم الحكومة) الذين كانت لي معهم جولات معارك وصدامات منذ أيام المعهد، وخصوصاً، بعد فوزي بالجائزة الأولى للمهرجان الشعري (قلم باركر 45!).. أي أن هذا الفوز، عدا ما ولّده من غيرة في نفوس الشعراء البعثيين، جعل مني وجهاً معروفاً، في المعهد والجامعة المستنصرية (كان طلاب المعهد يشغلون قاعاتها الكبيرة)، بل حتى في عدد من كليات جامعة بغداد. مشاركتي في المهرجان الشعري المذكور كانت لعبة تحدّ وولدنة.. صحيح أنني كنت طالباً متفوقاً في درس (الإنشاء) أيام الدراسة الثانوية، لكنني لم أجرّب كتابة الشعر، إلا غزليات مراهقة كأفخاخ غرامية، لكن قصيدة المعهد كانت جادة (بمقاييس الشباب المبكرة) وكنت أعرف وأدرك: ثمة تأثيرات فاقعة في تلك القصيدة من محمود درويش وبدر شاكر السياب وسعدي يوسف، بل ثمة لمسات واقعية حتى من روايات نجيب محفوظ ومكسيم غوركي قبل أن أتعرف، بشكل جيد على عالم فيودور دوستويفسكي المركب، لأتورط، لاحقاً، بتنوع قراءاتي، وبصري كاد أن يفقدني الكثير من التركيز المعرفي، إذا كان ثمة تركيز في عالم المعرفة الواسع والصخّاب والمتناقض. بعد تلك القصيدة أحسست بأنني أتحسس وقع أقدامي قبل أن أتلمس الطريق برمته. لكنني حملت قصيدة جديدة، أو ثمة من حملها نيابة عني (لا أتذكّر بالضبط) إلى جريدة (الفكر الجديد) وكانت هذه الصحيفة بمثابة انطلاقة تجريبية لما ستكون عليه (طريق الشعب) فيما بعد.. ولم يمر أكثر من أسبوع حتى فوجئت بها منشورة في الصفحة الثقافية إلى جانب أسماء كتاب محترفين، ولأول مرة أرى إسمي مخطوطاً والنص مصحوباً برسمة تزينية من الفن الحديث (أظنها للشاعر والفنان فائز الزبيدي).. من هنا ثبتت علي التهمة القاتلة (شاعر شيوعي)، غير أن الحظ الحسن، وهو نادر في حياة أمثالي، أن الضباط وضباط الصف لا يقرأون الشعر أو غير الشعر، إنما كان خوفي الشديد يأتي من زملاء الدراسة الذين تسوقوا معي إلى المعسكر نفسه (معسكر الرشيد – مدرسة القتال) ما أغلظ الإسم!. أما الهجوم النقدي فلم يأت من أحد غير الشيوعيين أنفسهم! الهجوم لم يتعلق بقوة القصيدة أو ضعفها، بل بمكوناتها الداخلية (المضمون كما يفضل الشيوعيون) فسرعان ما ظهر مقال للمرحوم هاشم الطعان يلوم فيه الشعراء الجدد على ضبابية الرؤية وحيرة النظر في قصائدهم وبرمهم بالجانب المشرق من الحياة الجديدة في العراق، والمقصود هو تجربة (الجبهة الوطنية القومية التقدمية). توضيح: لم أكن شيوعياً ، بعد، في الفترة التي بدأت فيها بنشر قصائدي في الصحف الشيوعية، لكنني كنت قيادياً في منظمة الطلاب (اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية) وهو من المنظمات التي يرعاها الحزب ويقودها (في نظامها الداخلي فقرة تقول: منظمة مهنية غير سياسية!) وهذا ما كنت أخوض بسببه كثيرا من الجدل داخل المنظمة.. لكن معظم أصدقائي، في سنّي أو أكبر مني، كانوا شيوعيين، ولم يكن لدي أي صديق بعثي.. كان ثمة شعراء وكتاب وصحفيون من جيلنا بعثيون أو مؤيدون أو متعاطفون أو انتهازيون. الأقرب لي من أبناء تلك الحقبة هم شاكر لعيبي (تونس) وهاشم شفيق (بريطانيا) وخليل المعاضيدي (استشهد في السبعينات) وخليل الأسدي (بغداد) وعدنان محسن (فرنسا). وثمة طبعاً أصدقاء من أجيال أخرى، سبقوني في النشر والعمل في الصحافة، سنة أو سنتين، مثل مخلص خليل وجليل حيدر ووليد جمعة وأصدقاء آخرين، لاحقاً، تعمقت صلتي بهم خارج العراق، مثل فوزي كريم وصادق الصائغ وحميد الخاقاني وعبدالكريم كاصد ومهدي محمد علي.. على أن لي أصدقاء رائعين من خارج الوسط الثقافي، أشعر معهم، بحرية أكبر! علاقتي بسعدي يوسف غريبة، رغم حميميتها، ومن ناحيتي أخاطبه في الحديث المباشر أو في الهاتف أو عبر الإيميل بـ (أستاذي وصديقي) حتى بعد مناوشات ومواجهات تتعلق بالشعر ونواحيه، وللرجل فضل، من جانبه، بخصوص تقبله لنقدي الحاد وتسامحه أيضاً.. وله فضل سابق، منذ سبعينات بغداد، في نشر قصائدي عندما كان مشرفاً على ثقافية (طريق الشعب) وسمعت من آخرين (ولست متأكداً) أنه هو الذي رشحني للمشاركة في أمسية شعرية عام 1972، وكنت أطير شكيراً، أقيمت في جمعية الفنانين التشكيليين، ببغداد/ الكرخ، ولم أكد أنشر سوى بضع قصائد، وأتذكر أن الرجل شد من أزري، قبيل الأمسية بقليل، في حديقة الجمعية وضيّفني، قنينة بيرة (فريدة) "جرعة للشجاعة" كما قال.. وكنت أصغر شاعر في الأمسية، وبين من أتذكرهم من المشاركين: سعدي يوسف ومخلص خليل، وأظن (غير متأكد) علي جعفر العلاق ورياض قاسم.. وربما صادق الصائق. سعدي يكرر: عواد ليس من تلاميذي!. أسباب كثيرة جعلتني أقل زملائي نشاطاً في النشر وطباعة الدواوين وعملاً على تسويق نفسي وكتابتي، ولا مجال لذكرها، منها لا جدوى الشعر في أمة لا تقرأ، غير أن الخوف من النشر في صميم تلك الأسباب، ومنها إحباط أعقب طبع كتابين، أحدهما شعري بعنوان (من أجل الفرح أعلن كآبتي) الذي صدر في بيروت عام 1982 وكنت حينها نصيراً مقاتلاً في كردستان ولم أتمكن حتى من تصحيحه، وانطوى الكتاب في فوضى الحرب الأهلية اللبنانية، والثاني كتاب نثري يتخلله بعض القصائد بعنوان (حدث ذات وطن – هامش عراقي) صدر في دمشق، فمنعته الرقابة السورية (بعد أن طبع!) ولم يوزّع، وهنا لا بد أن أشير للدور الكبير الذي لعبه الأستاذ فخري كريم، شخصياً، في دفعي وتشجيعي لطباعة الكتابين.. المغدورين من تأليف: شاعر مغمور الشاعرُ وسط المسرحْ ليرى، في ما يرى النائم، ثمّة نوراً يسقطُ من فانوس الله يتلو كلماتٍ لم يسمعها أحدٌ ثم يغادر مسرحه الخالي يعتتم المسرحْ تعتتم الكلماتْ تعتتم الخطواتْ تعتتم الروح الأمّارة بالضوءْ يعتتم الشاعرُ قبل سقوط الكلمات المُرّةِ جبٍّ لجبٍ وعميقْ تتلقفه حورياتٌ لتطير به فوق غمامٍ أخضرْ فتضجُّ القاعة بالتصفيقْ.... 6 تموز (يوليو) 1996
nasir_awad@hotmail.com لندن – 28 أيار (مايس) 2010
|
|
||
|
|||