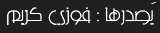|
السبعينيات : أصوات رصاص في بناية مهجورة
محمد غازي الاخرس
مدخل
في صورة سيريالية لا ادري لم تلح عليّ، غالبا ما أتخيل سامي مهدي وكأنه أحد أبطال أفلام الأكشن الستينية: رجل عصابات أصلع الرأس يخبئ مسدسا تحت معطفه الغامق ويتأبط جريدة للتمويه على أناس ما يطاردهم او يطاردونه، لا فرق. في المشهد الذي أتصنعه الآن يلج "بطلي" فجأة إلى بناية مهجورة ثم يتجه إلى مصعد ما في الركن. ينتظر مصيخا السمع لخطى أعداء يتوجس منهم خيفة. ها هو يسحب مسدسه بسرعة ويتوارى داخل المصعد ليعم هدوء تقطعه بضع رصاصات تنطلق داخل البناية. يرتفع المصعد مثل روح واهنة الجناح، ثم بشكل مباغت يتوقف في الوسط. تنطلق رصاصة وحيدة من أعلى ثم ينزلق المصعد إلى أسفل بسرعة وكأن قائده يحاول الخلاص من مأزق او يجاهد ليلاحق أناسا يعرفهم. بعد ذلك يرتفع المصعد مع لعلعة رصاص يتبعه تكسر زجاج في الجوار. بعد حين يعم هدوء مريب في البناية، هدوء طويل لا يقطعه سوى صوت المصعد الهابط بروية. ينفتح الباب عن "بطلي"، الجريدة لا تزال في يده مطوية بعناية وقع أقدامه الوحيدة توحي بثقة مطلقة. انه يبتسم وهو يخرج من البناية المهجورة . هل انتصر على أعدائه المتخيلين ؟ ***
المشهد السينمائي الذي قصصته توا ليس خيالا محضا، ففي ديوانه "الزوال"، يوفر لنا الشاعر سامي مهدي عددا وافرا من الصور المشابهة : أناس يقتلون فجأة، أجساد يأكلها القراد، مصاعد تحيّر راكبها ارتفاعا ونزولا بينما الآخرون ينتظرون هبوطه لقتله او احتضانه. بل في واحدة من القصائد يخيل لسامي مهدي أن أصدقاءه يقتلون أمامه في المطارات. الحق أقول أن ديوان "الزوال" هذا ربما كان من اغرب الدواوين التي قرأتها فهو يتوفر على كم من العنف يجعل القارئ يشعر بالاختناق فعلا : "فاصطنع لي مشهدا إذا شئت / منكسرا مثلا / أو قتيلا"(1) "هاهم في المحطات يدافعون / وما بين أبوابها / وسلالمها / يقتلون"(2) "بينما تتشرب أجسادهم بنقيع من الخوف والموت/ لا يأبهون له"(3) "ويتخذ الحب شكل السلالات/ والإرث شكل القوانين/ والبيت شكل القبور"(4) "مت قبل الأوان وبعد الأوان/ وافتقدناك حين هممنا جميعا بشتمك ../ لا .. / ليس في الأمر إلا مفارقة أنت سيدها / وهو الإعتراف، فلو لم تمت / لقتلناك من حنق/ وانقلبنا لنثأر من بعضنا لك/ فالخوف متصل بيننا " " وأنثر ما يتبقى على العابرين وأفزعهم : وسأضحك أضحك حتى أموت" ما أريد قوله في هذا المدخل ان ديوان "الزوال" هذا ربما يرسم صورة جانبية شديدة الخصوصية لمزاج السبعينيات حيث الاصغاء للمسدس يستحوذ على كل الحواس ويلقي بظله على كل الملامح بما في ذلك ملامح الضحايا .اقصد اولئك الذين كانوا أقرب الى الأشباح التي خيل لي أن سامي مهدي ظل مهجوسا بها اثناء مرحلة "الزوال". هل كانت تلك المسدسات وهمية؟ هل كان الرجل الأصلع الذي دخل البناية مجرد شرطي ام أنه شاعر متنكر في زي رجل عصابات ؟ سؤلان يمكن ان يلقيا بنا الى قلب البناية المهجورة وحينها فقط سنرى أي خوف رمزي صاغ ملامح تلك المرحلة .
المسدس والمسدس أيضا
كان ثمة، في السبعينيات، سيادة شبه مطلقة لمفهوم "المسدس" لا بوصف الأخير مجرد أداة أحالت إلى العسكر، منذ انقلاب بكر صدقي عام 1936 فقط ، بل بوصفه تلخيصا إنموذجيا لطريقة تعاطي السلطة مع الآخر، سواء كان هذا الآخر سياسيا أم مثقفا، وسواء انطلق في تعامله مع السلطة من منطلقاتها نفسها ،العنف ، أم كانت له رؤية مضادة. أولى الإشارات التي يمكن الانتباه لها، بهذا الخصوص، هو أن أول لحظة خصام تفجرت بين سلطة البعث والحليف الشيوعي كانت انطلقت على خلفية اكتشاف خلايا ماركسية في الجيش أعدم على أثرها ثمانية وثلاثون شيوعيا (5). بعث العراق ـ ص بدا مبرر السلطة شرعيا، للوهلة الأولى، لجهة أن تأسيس خلايا ذات طابع سياسي في الجيش يعد، حسب الأعراف التي تقوم عليها مبادئ مثل تلك المؤسسات التابعة للدولة، انتهاكا لأحد أهم المعايير التي سارت بموجبها الدولة العراقية منذ تأسيسها،على اعتبار أن الدولة هي الوحيدة التي من حقها احتكار العنف وممارسته بدنيا ورمزيا. العنف المقصود هنا لا يحيل فقط إلى احتكار ما يسميه بيير بورديو "قوى القهر" مثل الجيش والشرطة، إنما يشمل جميع أشكال العنف الرمزي الذي ـ وحسب تعريف بورديو ـ " ينتزع واجب الخضوع دون أن يتم الشعور به بوصفه خضوعا باعتماده على التماس جماعي ومعتقدات مرسخة اجتماعيا "(6) . نقص هامش بورديو في جدل ما حدث بالنسبة لأولئك الشيوعيين الذين أعلنت السلطة إعدامهم لم يكن حدثا خارج السياق . فالبعث الذي قرر منذ البدء احتكار العنف، شأنه شأن أية سلطة دكتاتورية أخرى، كان وجد منذ الأيام الأولى صيغة آيديولوجية مناسبة لملامح تلك المرحلة. وعلينا التذكير هنا بالعبارة التي راجت في كواليس المفاوضات التي جمعت الشيوعيين بالبعثيين للوصول إلى صيغة لتحالفهم . العبارة تقول ببساطة أن على من يريد الالتحاق بركب الثورة "الالتزام بعدم إيجاد ولاءات خاصة داخل القوات المسلحة غير الولاء للثورة "( 7) حازم صاغية بعث العراق ص 84 0 . الرسالة كانت واضحة إذن : أيها الرفاق الشيوعيون لا تقتربوا من محرمات الدولة ، دولة البعث، وإلا فالموت بانتظاركم. حادثة اكتشاف الخلايا الماركسية في الجيش التي ردعت بقسوة، ربما جاءت في وقتها تماما. ذلك أن التحالف الذي عول عليه الطرفان، كل حسب وجهة نظره ومصالحه، كان وصل إلى طريق مسدود بعد أقل من خمس سنوات من إعلانه. السبب لا يعود إلى اختلاف وجهات النظر، كما يعتقد الكثيرون، قدر عودته إلى أن البعث الذي استولى على السلطة بعد الثلاثين من تموز عام 68 لم يكن ، بأي شكل من الأشكال ، نفسه الذي استولى على السلطة عام 1963، وفقدها بعد أشهر. الكثيرون ممن كتبوا حول هذه المسألة يصرون على الحديث عما أسموه "عقدة فقدان السلطة" التي ضغطت على قيادة الحزب العائدة إلى المشهد. لكن بعيدا عن هذه العقدة التي تمتلك الكثير من الصدقية، علينا الانتباه للقيادة الجديدة والتركيز على معطى سيكون حاسما في السنوات اللاحقة . فالأخيرة ستبدو كثيرة الاختلاف عن قيادة الحزب التي استولت على السلطة في الثامن من شباط . نحن ،هذه المرة ، أمام رجال بلباس مدني ، لا عسكري ، لكنه لباس يشبه ألبسة رجال العصابات الذين يمكن رؤية شبح المسدسات تلمع خلف معاطفهم. التشبيه ليس مجازيا أبدا، كلا، كان الحدث واقعيا لدرجة الغثيان: المسدس بطل المشهد الجديد. أنه موجود وشغال، ويمكن أن يطلق النار في أية لحظة، ويحسم الأمور بطريقة لا عهد للعراق بها. لنتأمل الحادثة الأشهر التي وقعت بعد ثلاثة عشر يوما من الانقلاب: صدام حسين وصحبه يدخلون غرفة رئيس الجمهورية، وفي الوقت الذي ينتبه عبد الرزاق النايف، رئيس الوزراء وشريك الانقلاب ، إلى أن شيئا غريبا يحدث على مرأى من أحمد حسن البكر، يشهر صدام المسدس ويأمر النايف بمرافقته إلى المطار حيث يغادر الأخير إلى المغرب قبل أن يقتل بعد حين. مشهد ربما يذكر بمشاهد كانت تزخر بها سينمات بغداد آنذاك : مسدس يشهر فجاءة وضحية تغادر مسرح الحياة ،أو السياسة إلى الأبد (8) (العلوي العراق دولة المنظمة السرية ص 45 مؤسسة روح الامين الاولى 1426) . إن حادثة النايف التي دشنت ما يمكن تسميته مرحلة "المسدس" في العراق، كانت أبرزت إلى الوجود نمط القادة الجدد. القادة الذين بدوا وكأنهم نتاج مرحلة معقدة من مراحل الصراع السياسي، الملتبس، في الستينيات، بأنواع عديدة من الصراعات، صراع العسكر، صراع الأفكار، صراع الولاءات والانتماءات, بدءا من الولاء للمذهب مرورا بالولاء للمنطقة وانتهاء بالولاء للعشيرة والعائلة . بغض النظر عن ملامح هؤلاء القادة وهوياتهم وطريقة بروزهم واختفائهم من مسرح الأحداث، بدا من الأكيد أن صدام حسين سيكون بطل السيناريو القادم . فهذا الرجل هو نفسه الذي ذاع صيته منذ منتصف العقد، في أروقة حزب البعث، بوصفه "أبو مسدس" ، الذي رافق أشقياء الجعيفر وقادهم ، أكثر من مرة، كما تروي بعض القصص، لتهديد أصحاب الدكاكين ممن يمتنعون عن الإضراب الذي يدعو له البعثيون أحيانا. إنه صدام حسين ، المشرف على جهاز حنين الذي أسس بعيد كارثة فقدان السلطة عام 1964. والقادم الآن بالسلاح نفسه إلى واجهة الحدث . ((9) صاغية ص ) المهم أن البعثيين وصلوا السلطة أخيرا وبزي يختلف كليا عن زيهم القديم، لا عسكر في المقدمة، كما هو الحال في التجربة السابقة، سوى الرمز القديم، ابن تكريت، احمد حسن البكر، يتقدمه ابنه الروحي ، صدام حسين، الذي سيتعهد بالمحافظة على السلطة وعدم تضييعها. السبيل إلى ذلك إقصاء العسكر التقليديين, وتأسيس جهاز قوامه حراس جدد يتمتعون بروح هي خليط من روح العسكر وروح البعث. أما القائد فهو "السيد النائب" وليس الرئيس . قدر تعلق الأمر بمسألة احتكار العنف، تم الأمر بصيغة جديدة هذه المرة: بدل أن تتقاسم قوى القهر "الجيش والشرطة" احتكار العنف، الجيش بوصفه مؤسسة قمع خارجي والشرطة بوصفها مؤسسة قمع محلي ، سينحصر هذا الاحتكار، شيئا فشيئا، بقوى أمن ذات طابع سري، وسيكون على الجيش التحول، يوما بعد آخر، إلى مؤسسة تابعة، لإيديولوجيا السلطة، أولا ، ولرقابة قوى أمن ناشئة, متخصصة ومفصولة تقريبا عن كل مؤسسات الدولة . وهي قبل أي شئ ، ذات ولاء مزدوج ، لحزب البعث، المتماهي، بشخص معين ومنطقة معينة وعائلة بعينها. إنهم رجال صدام الجدد ، البعثيون، التكارتة، ومن ثم، أبناء آلبو ناصر، أعمام صدام حسين. تفاصيل ذلك التحول كانت حافلة على أن أبرز ما فيها هو بروز الشخصية المزدوجة لصدام حسين. ففي الوقت الذي يفترض بالرجل أن يكون بعيدا عن الأجهزة الأمنية، كونه مثل واجهة الحزب السياسية ، بدا الأمر بالنسبة للجميع وكأنهم أمام ظاهرة غير مسبوقة في العراق فالأمين العام المساعد للحزب ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة هو نفسه من سيشرف على "مديرية العلاقات العامة"، التي ستتحول بعد حين إلى "مديرية المخابرات العامة "، و هما معا وريثتا ما سمي بجهاز حنين الذي أشرف عليه صدام بنفسه منذ منتصف عقد الستينات (10) . (صاغية ص 49 وايضا ص 57 ) ترجمة كل هذه التفاصيل لا تعدو الآتي : لقد قاد صدام انقلابه بخطى بالغة البطء، وتحول بعد عام 1975 إلى المتنفذ الأول في مقاليد البلاد ، وترافق ذلك مع عملية إقصاء واسعة للمنافسين السياسيين، بعد أن تخلص باكرا من المنافسين العسكر. بعد ذلك كان على الرجل أن يعيد تنظيم الجيش بما يضمن السيطرة عليه، والطريقة المثلى هي تبعيثه ومن ثم تحويله إلى جيش "عقائدي" محاط بخليط من الأحزمة ، عائلية ومناطقية ليغدو من الصعب اختراقه، لا من قبل الخصوم السياسيين فقط بل من قبل الضباط من ذوي الطموحات البونابرتية ، أمثال عبد الرزاق النايف وناظم كزار وغيرهما. وفق هذه الرؤية تبدو لحظة اكتشاف الخلية الشيوعية رمزية ومناسبة تماما لإعلان نهاية الكرنفال الجبهوي الشيق، الكرنفال الذي لم يمنع الرفاق الشيوعيين من زرع خلاياهم في المؤسسة العسكرية المحمية جيدا. غير بعيد عن احتكار سلطة العنف الذي لم يكن بحاجة إلى كبير جهد لترسيخه وإضفاء لمسة جديدة عليه. كانت هناك مهمة بناء حقل صراعات جديدة من اجل احتكار امتيازات مرتبطة بهذا الحقل، نقصد حقل احتكار سلطة العنف، ذلك أن الأمرين متلازمان بالضرورة كما يقول بورديو، بمعنى أن الحصول على شرعية احتكار العنف البدني سيتمفصل، وهذه إحدى صفات الدولة، بطريقة لا فكاك منها بالحصول على حقل متجانس من سلسة احتكارات ثقافية واقتصادية واجتماعية تعتمل الدولة كلها (11). المسألة ، بهذا الصدد ، ستكون شديدة الخصوصية إذا ما تتبع المرء تلك الظواهر التي راجت في عراق السبعينات وغدت بعد ذلك ملمحا لا ينسى من ملامحه . كانت الأمور تجري بتناغم لافت وبسياقات متماثلة، وبأشكال تجد دائما طريقة ما لتلائم موضوعاتها، بدءا من البيت مرورا بالشارع والمدرسة وانتهاء باتحاد الأدباء أو جمعية الشعراء الشعبيين. الأمثلة في ذلك كثيرة، وإذا كان من الضروري أحيانا الالتفات إلى بعضها، فسبب ذلك لا يكمن في محاولة أرشفتها ، هنا، كما قد يظن البعض، إنما لاستباق أثرها الذي سيظهر لاحقا ،كما سنرى. الفكرة التي نريد التنبيه لها هي التالية: لا يمكن وضع حد فاصل بين مفهوم الاحتكار بوصفه مفهوما مركزيا تقوم عليه فلسفة السلطة، من جهة واستخدام العنف والعنف الرمزي كآلية يمكن أن تتجسد بأشكال عديدة ،من جهة أخرى . فعن طريق هذا الأخير يمكن لفكرة الاحتكار أن تتجسد ،بهذه الطريقة وتلك، وفي هذا الحقل من الممارسات أو ذاك . الحديث عن احتكار سلطة الكلام يبدو مثاليا، بهذا الخصوص، لاسيما أنه يحيل إلى الكلام بوصفه أفكارا بالقدر نفسه الذي يحيل إلى المؤسسات التي يتداول بوساطتها الكلام . والملاحظة التي يمكن الانتباه لها، بهذا الصدد، أن البعثيين لم يكونوا مهيئين، بعيد استلامهم السلطة ،لإعلان احتكارهم فورا للمؤسسات التي يتداول بها الكلام، لذا اضطروا إلى الإبقاء على العديد من القوانين التي كانت سارية قبلهم مثل قانون الصحافة والمطبوعات الذي استبدل عام 69 بقانون آخر(12) . (الروح الحية ص 244 ) هذه الفكرة لها علاقة بفكرة أخرى هي أن سلطة البعث التي امتلكت كوادر لا بأس بها مكنتها من ملء مؤسسات القهر"الجيش والشرطة" بسرعة كبيرة لم تكن تملك العدد الكافي من المثقفين القادرين على إنجاز المهمة نفسها . ليست هذه الملاحظة اختراعا شيوعيا ، بل إن أحد قياديي البعث كان وجد ما يكفي من الشجاعة للاعتراف بها بعد اعتزاله العمل السياسي . يقول هاني الفكيكي "إن تدني المستوى الثقافي بقي ملازما للبعث في العراق برغم كل الجهود التي بذلتها قيادات مختلفة وكانت روح العداء للشيوعيين تقيم عميقا في نفوس الأعضاء والأنصار .. فمشاعر الحب والتقدير أو الكراهية والبغضاء طغت على الرصانة الذهنية في محاكمة المسائل المطروحة " (13) . ولئن تحدث الفكيكي عن تدني المستوى الثقافي للبعثيين الأوائل وتغليب روح الانفعال والعاطفة ، فإنه يمهد إلى انعكاسات ذلك على علاقة البعث المتأزمة دائما بالوسط الثقافي مقابل حيوية علاقتهم بالأوساط الأخرى. يقول الفكيكي"صحيح أن جمهور البعث لم يخل من أدباء وشعراء ، إلا أنه بسبب حداثة عهده ، فضلا عن أفكاره القومية المحافظة، لم يستهو الفنانين، وفيما اقتصر الوجود الثقافي في أجواء البعث على شعراء وأدباء كعلي الحلي وشفيق الكمالي وأميرة نورالدين وأحمد عبد الستار الجواري ، وصديقة الحزب نازك الملائكة، انصب تركيز البعث على بناء المناضل الذي يتصدى ويصمد" (14). بالأحرى نحن أمام حزب عملي، لا نظري ، حزب انصب اهتمامه، منذ البدء، على تطوير قدراته لإنجاز مهمة الاستحواذ على السلطة ، وهو ما نجح به نجاحا لافتا فيما بعد. هذا التباين الجوهري في طبيعة الحزبين كان أدى لاحقا إلى بروز ظاهرة فريدة من نوعها، ففضلا عن الكراهية المريرة، كما يرى حازم صاغية،" أحس كل من الطرفين بحسد مر حيال الآخر فالبعث نظر إلى الحزب اللينيني الثاني عددا في العالم العربي نظرة مصارع إلى أستاذ مدرسة: الأول قوي بعضله، قادر على ممارسة القتل، لكنه يتمنى امتلاك شئ من معرفة الثاني ." (15) ومقابل تنعم البعثيين بالسلطة، كان لابد لشعور بالمرارة أن يعتري نفوس سادة الثقافة العراقية ، الشيوعيين الذين "حسدوا البعث كما يفعل فلاح بالكاد يكفيه قوته إذ ينظر إلى بدوي يغنم، بالسلب والنهب، قطيعا بعد آخر" (16). هذا الشعور بالمرارة لم يكن ليمنع المثقفين الشيوعيين والملتفين حولهم من ترسيخ تلك الهالة السحرية التي أحاطت بهم والمستمدة من تاريخهم الحافل بالإنجازات، وتقف على رأسها ارتباط حركة الحداثة الشعرية بهم . الأمر الذي برر، آنذاك، تلك القداسة الثقافية التي حازتها مؤسساتهم منذ الخمسينيات ووصلت ذروتها في الستينيات والسبعينيات. قدر تعلق الأمر بمرحلة السبعينيات التي شهدت سيادة شبه مطلقة للفكر اليساري، بدا الانتماء إلى الحزب الشيوعي، بالنسبة للمثقف العراقي، وكأنه بطاقة مرور إلى عالم المجد والشهرة . وعلى الرغم من جميع الادعاءات التي أطلقها أغلب المثقفين العراقيين، لاحقا ، من أنهم كانوا "لا منتمين" وأنهم حاربوا "الانتماء العقائدي"، وبعضهم يقصد تحديدا الارتباط بالحزب الشيوعي ، إلا أن أحدا منهم لن يستطيع إنكار ظاهرة استثمار قداسة الثقافة اليسارية ومؤسساتها للخروج بمظهر محترم وشرعي ، وربما معترف به. حين يستعيد شاكر لعيبي ـ مثلا ـ حادثة تكليفه هو زميله هاشم شفيق لتحرير صفحة أدب الشباب في صحيفة "طريق الشعب"، الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الشيوعي ، يذكر أن" الكثير من شعراء السبعينيات سينشرون أولى قصائدهم في تلك الصفحة" . ثم يمضي موضحا أهمية هذه المعلومة قائلا "كان النشر في طريق الشعب حدثا سارا بالنسبة للشعراء العراقيين جميعا رغم أبهة الصحافة الرسمية وسخاء مكافآتها. كان النشر فيها ـ طريق الشعب ـ مجدا شخصيا بمعنى من المعاني " (17) واقع الأمر أن وهما ثقافيا مثل هذا بدا حقيقيا إلى درجة كبيرة، إذ أن أغلب الأدباء والفنانين الذين اصطلح عليهم بـ"الكبار" آنذاك كانوا إما شيوعيين أو أصدقاء للحزب، بدءا من عبد الوهاب البياتي وسعدي يوسف ويوسف الصائغ مرورا بيوسف العاني وزينب وناهدة الرماح وضياء العزاوي وانتهاء بمظفر النواب وعريان السيد خلف وشمران الياسري وفؤاد سالم وغيرهم. كانت الظاهرة جد بارزة وتمتلك قدرا كبيرا من الإيهام لدرجة أن هاديا سعيد، الصحفية اللبنانية التي رافقت التجربة العراقية في السبعينيات، رأت أن الجو اليساري كان أكثر أغراء للاستقطاب، فهو " يستطيع أن يضعك في غلالة من الشعر والأغنيات والموسيقى والنجوم الثوريين فيما الجو العروبي البعثي لا يذكرك إلا بشعار مبتور وقصائد فخر سرعان ما تملها وتفضل أن تعود إلى امرؤ القيس والمتنبي وأبي تمام وأبي نؤاس، أي إلى الأصول قبل تأطيرها وتحجيمها. لم يطلق ـ الرفاق البعثيون ـ حركة لافتة في المسرح والموسيقى والرواية والغناء، كانت كل الأسماء التي سمعت بها ثم تعرفت على بعضها تميل إلى صالح ـ الرفاق الشيوعيين ـ "(18) ص 90 هذا السبب لم يكن الوحيد الذي حتم على السلطة البعثية الالتفات إلى المثقفين اليساريين عموما والشيوعيين بشكل خاص، للإفادة منهم . فعدا ذلك، كان ثمة مزاج عام ساد شعوب أغلب البلدان المتحررة حديثا من نير الاستعمار، وكان هذا المزاج يتجه بقوة نحو الأفكار اليسارية والاشتراكية ، بوصفها خيارا جديدا لهذه الشعوب بغية مقاومة الإمبريالية الأمريكية التي مثلت آنذاك وريثا طبيعيا للإستعمارين البريطاني والفرنسي. بل إن صدام حسين نفسه كان روج لنفسه صورة معينة راقت للشيوعيين، وذكرتهم ، ربما, بذلك الحلم القديم : العثور على كاسترو العراق, وانتشاله من براثن البرجوازية الوطنية. لم تكن هذه الرؤية نتاج مخيلة رومانسية طيبة تحلى بها مثقفو اليسار العراقيون, في تلك المرحلة, إنما هي رؤية سياسية رسمية عبر عنها قادة الحزب الشيوعي بطرق مختلفة، مخاتلة أحيانا وواضحة أحيانا أخرى. ولدينا هنا ذكرى أليمة يستعيدها فاضل العزاوي بطلها زكي خيري، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي, إذ اجتمع هذا الأخير, ذات مرة مع بعض المثقفين من ذوي الميول اليسارية في بيت هاشم الطعان، وكان العزاوي حاضرا إلى جانب آخرين أمثال عبد الرزاق عبد الواحد وحسب الشيخ جعفر واحمد خلف وفوزي كريم وحميد الخاقاني وصادق الصايغ وياسين النصير وابراهيم أحمد . لقد لام " زكي خيري الأدباء الحاضرين على رفض الانتماء لحزب البعث أو التعاون معه، داعيا إياهم إلى الانتماء إلى ذلك الحزب إذا لم يكونوا راغبين بالانتماء إلى الحزب الشيوعي ، بدعوى أن الرفيق فهد كان قد أوصى : قوو تنظيم حزبكم ، قوو تنظيم الحركة الوطنية " (19) . ( العزاوي 245 ) لقد كان من المنطقي , إذن, الالتفات إلى الخصوم الذين بدوا في تلك الأيام وكأنهم سادة الثقافة العراقية وأبرز الوقائع الملموسة، في هذا الصدد، هي استثمار إعادة تأسيس اتحاد الأدباء كمناسبة لإبداء حسن نية السلطة الجديدة تجاه الآخرين . فقد قرر البعثيون تقاسم مقاعد الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء مع الشيوعيين واتفق الجانبان في الاجتماع التأسيسي، عام 1969، الذي خصص لهذا الغرض"مناصفة الحصص بينهما، باسم السياسة ". وأعلن حميد سعيد في ذلك الاجتماع الذي عقد في مقر صحيفة الثورة أنه "تم الاتفاق سياسيا على توزيع مقاعد رئاسة الاتحاد بيننا وبين الشيوعيين وإذا كان الشيوعيون يرغبون في تقديم أسماء مستقلة فان ذلك سوف يكون ضمن حصصهم، ولكنهم أبلغونا أنهم لا يرغبون بذلك " (20). لم تكن هذه الحادثة سوى نقطة شروع لتقاسم احتكار سلطة الكلام ، مشفوعا برقابة بعثية صارمة على الرفاق الشيوعيين، رقابة قد تصل، أحيانا, إلى استثمار" قوى القهر البدني" التي امتلكها البعث لوقف بعض التجاوزات التي قد يرتكبها رفاق المرحلة. الوقائع التي يرويها أغلب اليساريين تكاد تكون متواترة بهذا الشأن، وهي وقائع قد تبدأ بمقال افتتاحي في صحيفة الثورة يرد به " مروان " ـ اسم مستعار ـ على قصيدة يلقيها جليل حيدر في اتحاد الأدباء( 21). ثم تتطور لتصل إلى اعتقال وتعذيب أدباء كيوسف الصائغ أو فاطمة المحسن، بل لعلها تصل الذروة، في أحيان معينة، إلى القتل، كما حدث مع خليل المعاضيدي، الشاعر السبعيني . وفي كل هذه الأحوال، تظل الرقابة البعثية صارمة، لا تفوتها شاردة ولا واردة . المهم أن حقل الصراع من أجل احتكار امتيازات مرتبطة باحتكار العنف كان في طريقه إلى الحسم دون مقاومة تذكر إذ سرعان ما فهم الشيوعيون الرسالة , وبدءوا في إعداد أنفسهم, لا للمواجهة, إنما لتغيير جميع استراتيجياتهم . بدلا من المغامرات غير المحسوبة،عليهم الآن التخفيف من لهجتهم وتشديد الرقابة الذاتية على أتباعهم, بل قمعهم إذا لزم الأمر. الحوادث الطريفة كثيرة، بهذا الصدد، فذات مرة ـ مثلا ـ رفض صادق الصائغ نشر قصيدة للشاعر شاكر لعيبي في صحافة الحزب الشيوعي بسبب "جنوح مهلوس وتداع مجازي" خشي أن يفهم خطأ من طرف السلطة .لذا كان على لعيبي نشر القصيدة في التآخي، لا طريق الشعب أو الفكر الجديد كما يفترض. (22) لكن الرقابة الذاتية لن تنفع شيئا أمام استشراء لغة القهر الثقافي المتصاعدة بدءا من عام 1977 . على الجميع الاعتراف, منذ ذلك العام ،عام اكتشاف الخلية الشيوعية في الجيش, أن الكرنفال انتهى وأن فجر المسدس الثقافي قد لاح فعلا، سواء خلف مكاتب المدراء أو تحت جاكيتاتهم، وهو على استعداد لتنفيذ تلك التهديدات المرعبة التي بدأ يتعرض لها اليساريون. كان سبق ذلك إجراءات رمزية عديدة مثل صدور أوامر نقل حكومية طالت مثقفين شيوعيين وحولتهم من مدراء عامين, في وزارة الإعلام ، إلى موظفين في وزارات أخرى مثل الري والمالية وغيرهما. كما حدث مع سعدي يوسف, مثلا , الذي نقل من وظيفة مدير تحرير في مجلة "التراث الشعبي" إلى موظف يقتعد مكتبا حقيرا في غرفة عفنة ومظلمة بوزارة الري (23). السؤال الذي يطرح هنا هو الآتي : هل كانت مسألة احتكار سلطة الكلام إحدى مخترعات سلطة البعث في السبعينيات؟ ثمة من تحدث, لاحقا, أي بعد تحرره من سلطة الأيديولوجيا الثنائية التي طبعت المشهد الثقافي آنذاك، عن احتكار ثنائي مارسه الحزبان المتحالفان على نطاق واسع كما سيورد الكثيرون لاحقا (24). لكن بعيدا عن تلك الاعترافات التي أصبحت من كلاسيكيات الثقافة العراقية ,علينا التنبيه إلى أن أغلب من تحدثوا عن هذه المسالة لم يكونوا أكثر من نتاج لتلك الثنائية. بمعنى أن الكثير من الشكوك يمكن أن تراود المرء وهو يقرأ اعترافات تنطلق, بعد عقود، من مثقفين نشأوا في ظل تلك المنظومة المعقدة , ثنائية الثقافة, أو تأميمها حسب وصف بعض السبعينيين. لم انتبه شاكر لعيبي ـ مثلا ـ بعد سنوات طويلة من ارتباطه بالماكنة الثقافية اليسارية إلى مساوئ الرفاق القدامى! هل كان اعترافه بريئا! بالمقابل, هل اضطر أبناء الجيل السبعيني حقا إلى التماس نوع من ازدواج الشخصية للفرار من الإذعان لسلطة الفكر السائد, كما يرى فاروق يوسف(24)، أم أن ذلك النوع من الازدواج كان, في الحقيقة, نوعا من "براغماتية" الغرض منها قطف ثمار مجد معين ربما يتمثل في إطراء ستيني على قصيدة تنشر في "طريق الشعب" أو في نقيضتها "الثورة"! الطريف أن الازدواج الذي يمثل به فاروق يوسف بتجربة الشاعرين خزعل الماجدي ـ "البعثي الذي رأى في التخيلات الجنسية نوعا من الإلهام الذي يضع الإنسان في متناول أسطورته، وهاشم شفيق، الشيوعي المنهمك في تفكيك أسرار اللذة الذاتية في اكتشاف العالم العابر"ـ ( 25) أن هذا الازدواج ربما وجد في السياق العراقي أفضل فرصة للتجسد، بغض النظر عما إذا كان المرء شاعرا أو ناقدا أو حتى صحفيا .بل حتى بغض النظر عن كونه عراقيا أو عربيا قذفت به الأقدار إلى بغداد. مرد الطرافة هو ما ترويه هاديا سعيد، اللبنانية التي انتظمت في الحزب الشيوعي العراقي, وعملت في " ألف باء"، مجلة الجبهة , فهذه الصحفية لم تتوقف عن النشر في "طريق الشعب" أثناء عملها في "ألف باء". هاديا سعيد التي خاضت ذلك النوع من الازدواج , مع زملائها, لا تزال تتذكر بمزيد من الحيرة :"عشت بدوري في تلك الفترة ثنائية من نوع آخر لأني ظننت أني سأجد دوري في الخدمة العامة وهو الدرس الأول الذي تعلمته في الصحافة، في التحقيقات التي أكتبها في ألف باء، كما سأجد مكاني في دائرة النضال والالتزام,عبر اجتماعي الحزبي بمسؤولتي الحزبية, ومن خلال المقالات التي كنت أوقعها باسم مستعار هو ـ عادل خليل ـ وتنشر في "طريق الشعب" . ما الحكمة من هذا الوضع المزدوج ؟ .. كأن الشخص من أمثالي كان يحتاج إلى شهادة وإلى ما يدرأ عنه تهمة الخوف أو الإهمال .. "(26) حقيقة الأمر أن الازدواج الذي تبرره سعيد, الصحفية الشيوعية , بالبحث عن الانتماء أو الهوية, الانتماء لمهنتها أو لأفكارها السياسية, هو ذاته الذي يبرره فاروق يوسف ,الشاعر اللامنتمي, بالبحث عن الشعرية وعوالمها. ولئن ألقى الأخير باللائمة على "سوء الحظ التاريخي" الذي جعل أبناء جيله " اللامنتمين" يدورون في فلك تلك الدائرة التي طحنت الكثيرين منهم ؟ فإن أحدا لن يقدر الآن على إعادة الزمن إلى الوراء, للخلاص من تلك الماكنة. كل شئ تم بنجاح , الازدواج مضى إلى نهايته صانعا لنا تاريخا ثقافيا كاملا, تاريخا سيسمح, بعد أكثر من عقدين, بانتقال الفهم ذاته إلى المنافي التي وصتلها الماكنة اليسارية. نقصد الصراع لاحتكار سلطة الكلام, وهو ما لا يمكن حدوثه دون استعادة شبح المسدس القديم, المسدس البعثي الذي لا تزال ذكرياته المريرة تخيم في نفوس الرفاق, رفاق سعدي يوسف الذين وضعت المسدسات في أفواههم , ذات يوم , وهم يقادون إلى قصر النهاية ، حسب توصيفات الشاعر العراقي الأشهر أثناء دفاعه عن الرؤية التي عرضها في مبادئ البرلمان الثقافي. في أحد الحوارات التي أجريت مع سعدي يوسف، وهذا ليس مصادفة ، يسأل المحاور عن مغالطة تراءت له في بيان كان اصدره يوسف ورفاقه ابان تأسيسهم ما أطلقوا عليه "البرلمان الثقافي" ، حدث ذلك في لندن عام 2000 ، إذ في الوقت الذي يدعو البيان إلى العمل الثقافي ، ترد منذ البداية، إشارات سياسية معينة، من قبيل استبعاد المثقفين "القتلة"، فيجيب سعدي " هذه ليست سياسة، كل ما نريد قوله أن القاتل بالمسدس لا يسمح له بالجلوس مع هاشم شفيق ، الوديع الذي لا يستطيع حتى أن ينتف دجاجة ، هذه ليست سياسة، هذه أخلاق" (27). مرحلة المسدس لم تنته إذن بخروج الضحايا ،بل هي مستمرة ، شغالة وفاعلة ، لا في "المفردة" التي طالما كررها المثقفون اليساريون وهم يستذكرون تجربة صراعهم المرير مع البعثيين ، لاسيما في السبعينيات ، إنما في تبني موقف صارم مما يسمى بـ "مثقفي الداخل" الذين خرجوا من العراق زرافات ووحدانا بعد حرب الخليج الثانية. فالعديد من هؤلاء الأخيرين كانوا، حتى وقت قريب ، من حملة المسدسات ، الحقيقية والرمزية ،حسب رؤية سادت في أوساط المتشددين من مثقفي المغترب على رأسهم سعدي يوسف. لكن الأمر هذا، أمر المسدس البعثي ، كان حسم باكرا ، بالنسبة لمثقفي السلطة ونفي نفيا جازما. وهنا علينا استعادة تلك الصورة التي يتخيلها سامي مهدي لـ"عبد الله الموهوم" ، أو سعدي يوسف الذي أهديت له القصيدة الشهيرة عام 1979، سنة خروجه من العراق. يرسم سامي مهدي الصورة التالية لثقافة المسدس :
عبد الله الموهوم إلى : س. ي
جنة هي , أو لعبة صرت تتقنها وتزوقها بيديك ؟ أنت تنشئ مما توهمت زنزانة وتجند في بابها شرطي وتصطنع الرعب منه .. وإذ لا يجاريك تحشو مسدسه بالرصاص وتغريه أن يطلق النار, غيضا,عليك أنت لم تتغير إذن وهو الوهم تسعى إليه , إذا ما ابتأست, فيسعى إليك
( ديوان الزوال ص 25 )
مشهد أخير
قد لا يكون المشهد الأخير مفاجئا ابدا . لا يتعلق الأمر بسامي مهدي الذي كثف مزاج السبعينيات التآمري في ديوانه ذي العنوان الدال" الزوال" ، انما يشمل الأمر جميع من وجدوا أنفسهم عالقين بين الظلمة والفراغ ، بين ذلك الغموض الذي يلف المكان أسفل المصعد وبين ذلك التحليق باتجاه فراغات غير مرئية يمكن التطلع اليها اعلى المصعد. كان جميع المطاردين والمطارَدين في البناية المهجورة عالقين في تلك اللحظة العدمية، لحظة ارتفاع المصعد وهبوطه في بناية السبعينيات الغامضة. المشهد الأخير يرسمه سامي مهدي ببراعة منقطعة النظير ، لنقرأ
" صاعد أنا او نازل لست أدري فما بين حدين من ظلمة و فراغ يعلقني مصعد لا قرار له بينما يقف الاخرون هنا وهناك على ريبة بانتظاري " (28)
هوامش 1ـ ينظر مهدي ، (سامي) ، ديوان" الزوال" دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد الطبعة الاولى 1981 ص 22 2 ـ المصدر نفسه ص 56 3 ـ المصدر نفسه 4 ـ المصدر نفسه 5 ـ صاغية (حام) ـ بعث العراق ، سلطة صدام قياما وحطاما ـ دار الساقي بيروت الطبعة الاولى 2003 ـ ص 42 6 ـ ينظر أوكان (عمر) ـ مدخل لدراسة النص والسلطة ـ أفريقيا الشرق 1991 ص 24 و26 7 ـ صاغية (حازم) ـ مصدر سابق ص 84 8 ـ العلوي ، (حسن) "العراق دولة المنظمة السرية"ـ مؤسسة روح الامين ـ الطبعة الاولى 1426 هجرية ص 45 9 ـ صاغية ، (حازم ) ، مصدر سابق ص 42 10 ـ المصدر نفسه ص 57 وايضا ص 49 11 ـ بورديو ـ بيير ـ مصدر سابق 12 ـ العزاوي ،(فاضل) " الروح الحية،جيل الستينات في العراق" منشورات المدى ـ الطبعة الاولى 1997 ص 244 13 ـ الفكيكي ، (هاني) " اوكار الهزيمة ـ تجربتي في حزب البعث العراقي" ـ دار رياض الريس ـ لندن الطبعة الأولى ص 168 14 ـ المصدر نفسه 15 ـ صاغية ، (حازم) ، مصدر سابق ص 79 16 ـ المصدر نفسه 17 ـ لعيبي ، (شاكر) ، " الشاعر الغريب في البلد الغريب" ـ دار المدى ، الطبعة الأولى 2003 ص 110 18 ـ سعيد ، (هاديا) ، " سنوات مع الخوف العراقي" ـ دار الساقي بيروت الطبعة الأولى 2003 ص 90 19 ـ العزاوي ، (فاضل) ـ مصدر سابق ص 245 20 ـ المصدر نفسه ص245 21 ـ المصدر نفسه ص 90 22 ـ لعيبي ، (شاكر) مصدر سابق ص 142 23 ـ العزاوي ،( فاضل )، مصدر سابق ص23 24 ـ المصدر نفسه ، ص 24 25 ـ يوسف ، (فاروق) " صحيفة "الراية" القطرية بتاريخ 13 نوفمبر 2004 26 ـ سعيد ، (هاديا) ، مصدر سابق ص155 27 ـ يوسف ، سعدي ، صحيفة "القدس" العربي اللندنية العدد 3344 بتاريخ 10 شباط عام 2000 28 ـ مهدي (سامي) " الزوال " ص9
|
|
||
|
|||