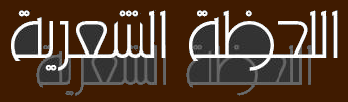|
حوارات عابرة للزمان باسم فرات
في اتصالي الهاتفي الأخير، مع سركون بولص، وحين أخبرني أن الأمر جاد هذه المرة، شعرتُ بألم يعتصرني، ورحتُ أقنع نفسي قبل أن أقنعه أنها سحابة وسوف تمضى بعيداً. لكني حين قرأت خبر نعيه في وسائل الإعلام، بكيتُ دون إرادة مني، كان الدمعُ ينهمر، كمن فقد أباه. لم يكن سركون بولص أبي بكل تأكيد، فكلانا يرفض الأبوة، وهي واحدة من خصال كثيرة لها هوى في نفسي، وجدتها لدى الراحل الكبير، لأن الشاعرَ تلميذ في مدرسة الجمال، وعليه فهو أبعد ما يكون عن الواعظ والأستاذ وسوى ذلك، أو بعبارة أخرى هو نقيض الأب، لأنه الابن العاق دائماً وأبداً، لكنه ليس ابن أحدٍ أيضاً، إنما ابن نزقه وحماقاته وتجاربه وهوسه بالجمال. من جملة الأمور التي أكبرتُ فيها سركون بولص، هي أنني حين حصلت على رقم هاتفه، واتصلت به، مبدياً رغبتي في أن يكتب كلمة الغلاف لمجموعتي الثالثة "أنا ثانية ً" جَرّنا الحديث للعراق ولغاته وفئاته، فقلتُ رأيي الذي طالما رددته وهو "أن لا وجود للغة آشورية أو كلدانية، بل هي سريانية (السورث عند الناطقين بها، وسِرْيَكْ، كما تسمى باللغات الأوربية)، وأن الشعوب والأقوام التي سكنت مناطق الوفرة، هي خليط من جميع سكنة المنطقة على مرّ العصور. وقد ناقشته معترضاً على بعض ما جاء من أجوبته في الحوار الذي أجرته معه مجلة بانيبال. كان الحوار إيجابياً، لم ألمس منه إلا التواضع في النقاش. ردة فعل سركون بولص بعد ذلك، طلب أن أرسل له المجموعة، ليطلع عليها ويرى، فقلت من جانبي، إنني سوف أرسلها الآن. أرفقتُ رسالة مع المجموعة، ملخصها أن هذه المجموعة بين يديك الآن، فإن وجدت فيها ما يستحق أن يضع سركون بولص اسمه عليه، فهذا مدعاة لفرحي، ومسؤولية سوف أبذل جهدي كي أكون أهلاً لها. بعد أسبوع، اتصلتُ به، فبادرني بجملة أربكتني لتواضعها وإنسانيتها، إذ قال لي بالحرف الواحد: "اليوم تسلمت بريدك وقضيتُه مستمتعاً بقراءة "خريف المآذن" وهنا وهناك، شكراً لك يا باسم، وبعد أسبوع من الآن، سوف تصلك كلمة الغلاف"، وقد وفّى بما وعد. من هنا بدأت العلاقة، فرحت اتصل به بشكل مستمر، لنتحاور في شتى الأمور، وبخاصة في هموم الشعر والحداثة ووضع العراق، وكانت علاقتنا ندية، لم يعاملني كتلميذ أو كشخص يصغره بربع قرن تقريباً، بل كان يناقشني ويسألني ويجيب عن أسئلتي وكأننا من عمر واحد. أحياناً نتفق تماماً وأحياناً نختلف قليلاً أو كثيراً. وفي الوقت الذي كنتُ أحاول جاهداً أن أغرف فيه من معين ثراء ثقافته، كان هو يستفزني ويأخذ النقاش إلى المناطق التي يعتقد أني غنيّ بها، كالحديث عن الأجيال الجديدة في الوطن وتاريخ العراق وما إلى ذلك.
آراء وأمنيات طالما حدثني عن السياب وسعدي يوسف، وعن رغبته إن سمحت له الظروف بإعداد دراسة عن دورهما في الشعرية العربية، فهو يعدهما أكثر شاعرين عراقيين قدما تحديثاً ومنجزاً للشعرية العربية. مرة قادنا الحديث إلى أدونيس وعمله "الكتاب".ابتدأ حديثه بالقول "حينما نريد الحديث عن أدونيس، فنحن نتحدث عن كبير وعن شاعر لعب دوراً مهماً في حركة الحداثة العربية، ومن هنا فإن "الكتاب" عملٌ لا شك في أهميته، ولكن هل تاريخنا كله دموي؟ أليس فيه إشراقات هائلة، أعتقد أن أدونيس تطرفَ بعض الشيء. تحدثنا عن الترجمة، فذكر أن جميع الترجمات لشكسبير لم تفه حقه، وحين سألته: ولماذا لا تتصدى لترجمته، قال:"إن ذلك يحتاج الى تفرغ تام، ووقت طويل، وأنا ليس لدي الوقت "هل كان يتنبأ بموته؟ كثيراً ما تحدثنا عن الشعر الفرنسي والشعر الأنغلوسكسوني، وكان يفضل الأخير على الأول، فلطالما ردد جملته الأثيرة والتي تعبر حسب رأيي عن شخصية سركون نفسه، ألا وهي "شعر حياة وليس شعر لغة" وكان يعني أن الشعر الفرنسي شعر لغة بينما الأنغلوسكسوني شعر حياة. وهو ما نلاحظه في شعر سركون ذاته، حيث تحضر الحياة، وتغيب اللغة، تبرز اليوميات والمشاهدات والتجارب والهامش، وتضمحل البلاغة والاستعراض اللغوي، توجد التجربة بحيويتها وبساطتها وحرارتها، ويغيب المعمار البلاغي الفخم، تاركاً مكانه لبلاغةٍ خاصة لم تخضع لمعاول النحويين والبلاغيين والنقاد، بلاغةٍ تملك مقومات القرية وبراءتها وعفوية المدن البعيدة عن سلطة التراث البلاغي العربي، وهو ما دعاني إلى تسميتها بالقصيدة الشَرَكية، لأن عبيد البلاغة وحراسها رفضوها، أو تجاهلوها، وأما دعاة التجديد والحداثة ممن لا يملكون الأسس الثلاثة التي تستند إليها العملية الابداعية، وهي الموهبة والتجارب وسعة الاطلاع وتنوعه، فقد راحوا يقلدون هذه القصيدة بطريقة ساذجة، لتتحول نصوصهم الى حكايات جد عادية أو خطب ٍ خاليةٍ من الفخامةِ والصراخِ العاطفي الذي يشدّ الجمهور، في وقت يفتتح سركون بولص ديوانه "عظمة أخرى لكلب القبيلة" بـ: كرسيّ جدّي ما زال يهتزّ على أسوار أوروك
تحتَهُ يعبُرُ النهر، يتقلّبُ فيهِ الأحياء والموتى.
ثم ينهي الديوان قائلاً:
يهتزُّ كرسيّ جدّي المواجه للنافذة. يهتزُّ على أسوار أوروك. يهتزّ حتى وهوَ فارغٌ، لا يجلسُ فيه أحد.
هذا هو الشعر النقي الخالي من البهرجة والبهلوانية اللغوية والحكي والأخبار والتسطيح المبتذل، وهو ما انسحب على آرائه بالشعراء العرب الذين تأثروا بالشعر الفرنسي، حيث كنت اتخذ من رأيه بالشعر الفرنسي والانغلوسكسوني ذريعة لكي تنهمر عليه أسئلتي وتساؤلاتي، في محاولة مني للتخلص من زاوية المجيب والمتحدث التي حشرني فيها الى ركن السائل والمستمع، وكان يجيب بلغة خالية من الإلغاء والتهميش، مهما كان رأيه سلبياً بشعر أحدهم، وهي ميزة تحسب له تماماً. ومرة تناولنا في حديثنا، شعرية شاعر يكتب نصوصاً طويلة، أي القصيدة – الديوان، فراح يطرح رأيه شعرياً، مبيناً خطورة كتابة نصوص طويلة ومنزلقاتها، وخصوصاً الحشو الذي يضطر اليه الشاعر، مما يُحَوّل عمله الى فقاعات لغوية تدهشك في بادئ الأمر، ولكنها تتوضح في القراءة المتمعنة، القراءة الاحترافية، وكان يردف كل جملة يقولها نقداً بتجربة الشاعر إياه، بجملة ثناء وتأكيد على شاعريته. لم أكن أعلم حينها أن هذا الشاعر كان قد كتب مقالاً ضد سركون بولص، بينما كان حديث سركون عنه إيجابياً بلغة النقد الحقيقية التي لا تعرف الإطراء المجاني. كان يتابع ما ينشر هنا وهناك، ومرة أرسلتُ اليه روابط لمواقع عديدة بناءً على رغبته، وفي المكالمات الهاتفية التالية، راح حديثنا يتركز على هؤلاء الشعراء الجدد ( بالنسبة له ) ولم اكتف بهذا بل أرسلتُ اليه نماذج لشعراء عديدين، كان كالطفل الذي حظي بلعبته المفضلة، وقال لي: " أشعر بارتياح لوجود هذا العدد من الشعراء الشباب، فالمستقبل أمامهم وهو ما يمنحنا الطمأنينة، أن مستقبل الشعر بخير "، لم يتوان عن إبداء رأيه وإعجابه بأي شاعر حقيقي، ورغم أن عاطفتي أحياناً، تحثني كي أسأله عن فلان من الشعراء أو قصيدة ما إن كانت لي أو مما قرأتُ لآخرين، لكني وبالممارسة عرفت أجوبته، إن كان الجواب إعجاباً لا يتوانى عن إبداء رأيه والتحدث عن القصيدة دون الحاجة لسؤالي، وإن كان رأيه سلبياً، فأعرفه من خلال عدم إبداء رأيه أو من خلال قوله كلاماً عادياً ليس فيه " حماسة الطفل بلعبته المفضلة "، كلاماً لا يجرح ولا ينتقص من الطرف الثالث، ولكنه حتماً لا يخون الشعر. لا شكّ أن الراحل كان مهذباً، فطوال سنتين من مكالماتي الهاتفية معه، لم ألمس منه الا ما يسرّ، لم يلغ الآخرين، شعرياً أو سياسياً أو إنسانياً. وحين تناولنا أهمية الكلمة وقدسيتها، أخبرني عن يوسف الخال، وكيف أخذه الى ما يشبه الكهف أو الصومعة، وقال له ما معناه :" عليك أن تترهب في محراب الشعر كما يفعل الراهب، فالشعر بحد ذاته قضية كبرى"، مستدركاً إن على الشاعر أن ينعزل، ليس بمعنى العزلة الموحشة، وإن كان بامكانه فلا بأٍس ولكن العزلة عما يسيء للشعر، كإلغاء الآخرين والمناكفات وتحويل الشعر الى وسيلة وهو الغاية، وسيلة من خلال مدح الحكام أو ذم الأصدقاء لمجرد الاختلاف في رؤية الأمور، حيث هكذا أفعال وسلوكيات تحط من قدسية الشعر، بل وقدسية الكلمة، وإن الشاعر عليه ألا يضيع في متاهات الردود والمهاترات الكلامية، الشعر كما كان يردد، يحتاج الى أكثر من حياة، ومن السذاجة أن نعامله كجزء وهو الكل، وأن نفرط في أوقاتنا في ما هو غير شعري.
حسّهُ بالعدالة والانسانية: مازلت أرى رأيه في كركوك وعموم العراق، هو الرأي الأكثر صواباً متمنياً على الجميع أن يسير على هداه، إن أرادوا عيشاً حضارياً وحياة كريمة لهم ولأجيالهم، حيث كان يرفض أن تكون هناك مناطق لفئة دون أخرى، من خلال التسميات الدالة على قومية أو دين أو مذهب، بل كان يرى الغنى والثراء في التنوع والتفاخر به. وإذا كانت متاحف الدنيا تشهد والأرض وما تحوي من آثار على مَن هو صاحب الأرض الأصلي والأقدم، فإن الحس الانساني والشعور الوطني يحتم علينا أن نؤمن بشراكة الوطن ، حسب تعبيره.
وأخيراً حين مرض قبل سفره الأخير الى برلين بعدة أشهر، رحت أواظب على الاتصال به والاطمئنان عليه، لاحظتُ رغبته في التحدث لم تنقطع، وبعد أكثر من شهرين تحسن كثيراً، فهنأته، وبادرني شاكراً وممتناً وكأني طبيبه الذي شفاه، فاستغربت، لكنه عاجلني بكلام سوف أبقى أتذكره كلما قرأت مقالاً عن سركون، قال فيه: أشكرك كثيراً، فأنت لك الفضل وساعدتني كثيراً، مكالماتك المتواصلة سبب مهم في تَحَسّني...إلخ. وقد كان هذا كافياً لأفهم أنه يشعر بوحدة قاتلة، وهو بحاجة ماسة إلى التواصل، بل إني على قناعة لو أن ما كتب عنه بعد رحيله، قد كتب نصفه أو حتى أقل من ربعه بكثير في حياته، فلربما أجّلَ رحيله سنوات أخر.
|
|
||
|
|||