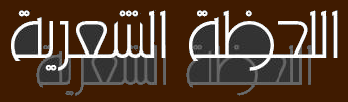|
أغلال الوجود الحر
طالب عبد العزيز
قبل شروعي بكتابة الفصل هذا عنه ،كان البريكان (لا زال حيا بيننا) لم تتخطفه المُدى بعد ،وكنت قد إستأذنته بهذه : 1 ما كنت لأفكر يوما بالكتابة عن الشاعر محمود البريكان، أبدا، لعلمي بحساسيته المفرطة تجاه مثل الاقتحامات هذه أولاً, ولاعتقادي بأن الزمن لم يئن بعد لركوب الأهوال، فهذا مركب صعب, ولن يكون الاختيار الأمثل بالنسبة لي, غير أني تصورته أو (رأيته) لا أذكر ، مارَّا قرب نصب الشاعر بدر شاكر السياب، عند حافة المدينة ،صديقه ،وشقيق تجربته في الريادة ،وابن مدينته ورحلته في الشعر والوجود, وسألت نفسي, تُرى كيف يفكِّر البريكان في اللحظة هذه بالذات ،حين يسقط ظلُّ التمثالِ (الشاعر) على الشاعر فيه؟ هل يُرعبُ المعدنُ الأسودُ الشاعرَ؟ أيّ حوار سيبدأ بينهما؟ وهل فرَّق المعدنُ الرحلة التي ابتدأت مطلع الأربعينات ؟ بدر على حافة الماء, بذراع لا تشير إليه, والبريكان فيما سيؤول الرواة والناسخون والتاريخ عنه , أيهما يبدأ الأخرَ بالسلام؟ السياب بجيبه المثقوب, والبريكان بصمته الذي نثقبه نحن (أصدقائه) بين الحين والأخر؟ السياب بوقوفه الطويل على حافة المدينة ،والبريكان بتجواله الوئيد, وهو يصفُّ خطواته على شوارعها خائفاً من المعري (صديقه القديم) الذي أمر الناس بأن يخففوا الوطء. لأن الأرضَ هذه من أجسادهم, أمام هذا, وغيره الكثير أردت أن أستأذنه غيرَ مرَّة, لأن الحديثَ عن البريكان تضيق لسعته الصدر, والمغامرة لم تنته بعد. أعترف بأني من القليلين الذين كانوا يختلفون على منزله في حي الجزائر... فقد مضى على زيارتي الأخيرة له أكثرُ من ثلاثة أعوام، وذلك لأني التقيهِ أحياناً، في الشارع فاحترمُ عزلته وأهابه, كذلك إني أحبُّ أن أنظر إليه بعيداعنه، أتأمل قامته الباهرة وهو يقطع شوارع وأزقة العشار جيئة وذهابا ،صُحبة نفسه وعوالمه أو صحبة أحد ولديه، فأقول معه ما قال في قصيدته (الطارق) : من الطارق المتخفي ترى؟ (شيخ عائد من ظلام المقابر) ..... (رسول من الغيب يحمل لي دعوة غامضة) ومهرا لأجل الرحيل؟ ****** حملت (كتاب انطولوجيا الشعر العربي) الصادر باللغة الألمانية ، له فيه مجموعة قصائد. أرسله بيدي الصديق الشاعر حميد قاسم من أبو ظبي، حين التقيته في بغداد , وقصدته في منزله ،كانت الشمس تحتجب خلف سحب شتوية ماطرة, اللوحة القديمة معلقة, أمامنا ،في بهو الدار الواسعة ،ساحل قريب ،وبحر متلاطم مترام ،فنار ودوارة ريح تتغير, غير أن الغبار كان يغطي تاريخ الأشياء (تاريخنا) ،الغبار زمن يكتبنا على الأشياء لنقرأه هرما وأغلالَ وقصائد. ها نحن معا على الأريكة، قبالة اللوحة ،النافذة خلفنا بستارتها القديمة ،النور القليل يضفى على المكان زمناً أخر (غبارا) المكان بتواريخه التي أعلمها والتي أتخيلها, البيتُ بانطوائه على هذه التواريخ ،المسرات القليلة التي اجتاحت خيال الشاعر, الآلام التي ينوء بحملها الناحلُ العملاقُ الشاعر الذي يرزح تحت نير الحرية والعبودية معاً, ووالتي لازالت أغلالها ترن في معصميه. كيف أذن؟ أنّى لي أن أبدا؟ وماذا تراني قائل: الشاعر الذي عندي لم يبلغ الحلمَ بعد, والقصائد التي أفرح بها في الليل، أخجل منها في النهار (حين كتبَ البريكان قصيدته ((قبر في المرج)) عام 1947 لم يكن أبي قد فكر بأمي بعد) كل ما لديَّ هو بعضٌ من صَلف الشعر والمغامرة وحياءٌ ظاهرٌ أتحدى به جبلَ الشعر الراسخ في أريكته،. الذي ظلَّ يُرعبني بسؤاله عن شعري وصحتي وقراءتي وأشيائي (إذا كانت عندي أشياء) ظلَّ يرعبني بسؤاله – أرأيتم كيف يُرعبُ غياب الشاعرُ حضورَ الآخرين- قلت له مستعيراً مقطعاً من قصيدته (نافذة الشاعر) يفتحها للنور والريح وعطر الأرض، يهجم منها صخبُ العالم/ يغلقها كأنما لآخر الزمان/ ومثلما يُغلقُ تابوتٌ إلى الأبد . ***** أنطفأ المصباحُ: فاختفى نصفُ وجهِ الشاعر, صرت أرى نصفه الذي يلي النافذة, مثل ممثل شكسبيري، كان يأتيني صوتُه مارا بغابات, لا أعرفها, متلاطماً مرَّة, وهادئاًَ أوبيراليا مرة أخرى, شَعْرُهُ الأبيض المُرخى على عنقه صار أكثر بياضاً .لكنه حينَ أزاحَ الستارة قليلا , دخلت شمس بيضاء بادرة, وقطرات مطر مرتبكة كانت تنقر النافذة, تتسمع لكلماته التي بالكاد أتبينها , كأنها تقول لي: الشاعر لا يقبل أن تُسترق منه النظرات. ظل يتحدث عن الرازي بنصفه المُضاء, بينما تحجبُ العَتَمةُ وجهي عنه, كنتُ مبهورا بحديثه الذي لا ينتهي, فأفكاره ظلت تشغلني عن حركة يده التي يستر بها فمه ،أو يثبت عويناته ،فلا يكاد ينهي حديثا بيننا ،حتى يعرج على فكرة ما، أراء وأفكار ،شخصيات وتواريخ، شعراء وروائيون ،مسارح وسيمفونيات ،أشياء لا يمكن أن تمر إلا على ذاكرة الكبار... (يكتب كتاباً عن الرازي في مطلع حياته الأدبية) ظل يتحدث ويومئ بيدين معروقتين, فأرى الأصابع النحيلة وهي تعبث بالتواريخ والأسماء والمدن والذكريات ،ثم يأتي ثانية بالحديث عن الرازي، متذكراً سنيه الأخيرة, حين أصابه الوهن، ليقول بلسانه: ( لازلتُ على حاليَ هذهِ, حينَ ضَعُفَ بَصري، وفُتَّ عَضُدي, أستعينُ بمنْ يكتبُ عنّي,... ) كان ينتقل بالحديث من أبن رشد إلى الغزالي, ثم يعود إلى المعرّي, ويتعجبُ من صبر المبدعين هؤلاء فيعظم إنجازهم، ويُكبر فيهم روحَ الوفاء والمطاولة والثراء ،ويثيرُه خلودُهم في الزمن. كنت أصْغي شاردا, أحاول أن أخدعه بإصغائي, أبدو معي,معه .. لكني في الحقيقة كنتُ أسرحُ بأفكاري بعيدا, تُرى أيتحدثُ شاعرٌ مثل البريكان عن الخلود؟ وهنا أستحضر قولة السَّياب فيه: (محمود البريكان شاعر عظيم, ولكنه, مغمور بسبب نفوره من النشر) ورشيد ياسين: (البريكان: يتقدمنا بمائة عام) وحسين عبد اللطيف: (شاعر طليق: جوال في ليل المعنى) بينما يقول هو: (اعتقدُ أنْ، على الشاعر الحقيقي أن يتحرك وحيدا, ضمن خلفية تاريخية مدركة وعبرها). أو... (المفكرون الحقيقيون رواد طرق... لا ينتظرون أن ترسم لهم خرائط) ويردد كثيراً بأن الحقيقة ليس لها زمن. ***** ظل البريكان أمينا لعوالمه, ينظر لتحقق تجربته الشعرية بعين العارف (المطمئن) وكانت تصدق آراؤه, وتترسخ يوماً أثر يوم، وهو الذي يقول دائماً, ويؤكد بأن( التجارب العظيمة إنجازات فردية,) والانتماء للشعر انتماء لوحدة الوجود, وهو إخلاص لأبدية تسعى لتحقيقها ثلة من الكبار الذين يتقدمون موكب النور, وهو ككل المعنيين بخلود الأشياء وانتصار الإنسان لا يألفه محيط معين, دأب الناس على تسمية أبعاده. ومعرفة حدوده, فالكون لديه أكبرُ مما هو مرسوم ومصور، والعلاقات والأواصر لأتفهم كما هي عند الآخرين. فيظن البعض بترفعهم ونفورهم من الظاهر والسائد والمعتقد بصمته. أنهم يذهبون إلى الغامض المتألق خلف الآكام, الذي لا يُمسَكُ ولا يُرى, كأنه يستشعر ويدرك, هكذا تبدأ محنتُهم مع العالم, أنها المعرفة المضادة, المتعارضة مع المعارف البسيطة, هي محنة العارف (الذي انفرطت مفاصله) كما يقول عبد الرحمن طهمازي. لم يستطع البريكان أن يتوحد مع (الحرية) فالكون ضيق, والخرائطُ التي رسمها خلال رحلته الداخلية تلتفت عليه, لأن الأبدية اختصرت إلى حاضر لا يعرف غده, مثله مثل الشاعر الروسي بوريس باسترناك الذي لم يستطع أن يتوحد مع الثورة، ولم يقرن حياته بنتائجها, كان يشار إليه بأنه عدو أيديولوجي, ومهاجر داخلي, والحقيقة أنه كان استثناءً لا يصدق في روسيا. (نحن أذن، لا نستطيع أن نعبرَ السياج دون أن نطأ نظام الكون) (محنة باسترناك- أدونيس). أراد البريكان عبر لغة مجازية, (حياة مجازية) والتي هي بالتأكيد- نتيجة طبيعية لقصر حياة الإنسان لديه- أن يُفصحَ عن نفسه، باشرا قات عفوية،هي الفردوس الذي دخله وحده ،وهي الخطى الخاسرة دائماً, لكنها الوحيدة, أراد عبر تجربة فريدة صادقة أن يجد نهايات سعيدة للعالم، أراد أن يعظَّم الوجودَ عَبرَ مهالكَ لابدَّ منها.
وحين مات محمود البريكان كتبت دون أن أستأذنه !!!
2 في المساءات الموحشة ،حين يترك الشاعر نافذة غرفته العلوية مفتوحة، يكون حفيف الريح قد خفَّ كلما ابتعد القمرُ الشتويّ الأصفر ، وحين تتعالى الآلات البوذية من مقطوعة سور الصين لـ ( ياني ) الإغريقي ، وينفرد عازف الفلوت بعيداً عن حشد الموسيقيين تتساقط أجزاء رقيقة من طبقة الملاط في السقف ، تسقط ُعلى الرأس الأشيب المأخوذ بمرح العازفين ، لن يجد مسوّغاً كافياً للفزع هذه المرة، إذ غالباً ما شاهد البقع الخضراء الرطبة أعلى السقف ، فهي تسقط حين يشتد الرعد في ليالي الشتاء ، وتسقط أيام الحروب، حين تمر الطائرات، وتدوي المدافع ،لكنها لا تُفزعُ الشاعرَ ، فقد ألِفَ الأشياء هذه ، ألِفَ حتى اختضاض الأبواب واهتزاز المصاريع . وحيدا يلتفّ محمود ببرنصه ذي الحزام المفتول ،لا زوجة ولا ولدان الليلة في البيت، وقد همدت المقطوعة على المنضدة الزان الدكناء ، وبعد أن تقاطعت أسلاك جهاز الكرامفون مع شبكة الأسلاك الأخرى حول السرير المنفرد منذ أكثر من عشرة أعوام ،الشاعر يحدّق في السقف الرطب المبلول بعين مفتوحة وحيدة هذه المرة ، فقد أسلم إحدى عينيه لما ظلّ في وحشة الليل من نجوم ، وانزلق تحت الغطاء منتظراً أن توقظه قصيدة ، بائعة قيمر ، طَرقاتُ صديق ، أو أصوات الأطفال في الزقاق الذي يشمس فيما بعد، غير آبه لشيء، فقد أعدّ للصباح مرآة الحلاقة وجهاز التسجيل والخطوات اللازمة لجلب الرغيف من البائع آخر الشارع ، وكذلك فنجان الشاي المعدّ سلفاً في غرفة المعيشة . الشاعر يفكر بطاغور ، يمجّدهُ كثيرا ، يتمنى لو أنه التقاه في متنزه عام أو في دار الأوبرا ، يفكر براقصات البولشوي النزقات اللواتي ابتعدن عن باسترناك ( هذا المنتفض في غابة الثلج ) وراح راقصاً أزلياً مع بجعات تشايكوفسكي البيض ( ليتني كنت أطلعته على ديريك ولكوت ، من المؤكد أن سيسحره هذا الكاريبي الرائع ، ومثله أشير للبحر الأزرق والخلجان التي ألهمني خرائطها ذات يوم ) نام البدويّ الذي لم يرَ وجهه أحد ، النجدي الذي انتزع الصحراء والرمل من جسده، واستقر في المدينة ،حتى صار متحفاً للأشياء الغامضة الغريبة . ذات يوم ،في القرون القريبة الماضية كانت ِ العائلةُ النجدية قد تركت خيامَها وهوادجَها وبراريها وانسلت في فجر رطب صوب بليدة الزبير ، حيث تستقر العوائل الحجازية العريقة ، ولما كان أهلُ البصرة منشغلين بالتنزه بين البساتين والتجوال بالعشاريات في الأنهار التي تخترق المدينة من كل صوب ، كان النجديون يشترون الضِيَاع والدور والمحال في المدينة المُبتاعة لهم ، حتى ملكوا مشرق ومغرب النخل وصاروا الأشراف والأسياد فيها مثلما كانوا هناك . وهكذا انحدر الشاعرُ محمود البريكان من أرفع بيوتات نجد وأكثرها عِزّاً وسؤدداً حتى استوطن هو وبعض إخوانه ضاحية الجزائر بالعشار . وصرنا نزوره ونتباهى بمعرفتنا به هو الذي قال لنا أنّ الشعر حياة . غطّى الشاعر رأسه ، وأطبق عينيه ، كان يدرك أن النافذة المفتوحة قد لا تدخل منها الشمس دائماً ، التهمَ السريرُ الجسدَ الفقيرَ وضاعت الصورةُ الشاحبة في ضباب الصور المتراقصة في الظلام ، وعلى الحائط ، تولستوي بلحيته الطويلة الشعثاء ، لوركا الذي اصطبغت شوارع غر ناطة بدمه في الربع الأول من القرن الماضي، ونيرودا بالرصاصات التي غيرت مجرى الشعر في أمريكا اللاتينية . في ليلة الجمعة ، في الثامن والعشرين من شباط ،حيث لم تكن السنة كبيسة ما فيه الكفاية،وفي فراشه الرطب الأحمر ، أُخرِجَ الشاعرُ ذو الطعنات السبع عشر وحيداً من داره ، وقد استعجل الناس دفنه ، لئن كان القبر المكان الوحيد الذي سبقنا إليه الشاعر محمود البريكان قد انغلق عليه إلى الأبد ، فإن الجرح العميق الذي خلّفه في الضمير الإنساني لن ينغلق أبدا ، ستظلّ الحراب أبداً تشير إلى كل ما هو وحشي ومطلق . لقد استُبيحَ الجسدُ الذي كنّا نضنّ عليه بالسلام الكثير،نخشى على تكسره بين القبلات والعناق، ونبتكر العذر تلو العذر حين نُسأل عنه في بغداد، أو في أيِّ مكان آخر ، ها هي صورته في الصفحة الأولى من الجريدة ممزق الصدر ، فاغر الفاه ، شاخص العين ، ترى ماذا كان يقول لو انه أفاق بعد سبعة عشر طعنة ليلة الثامن والعشرين من شباط حيث لم تكن السنة كبيسة بما يكفي لقتل شاعر .
|
|
||
|
|||